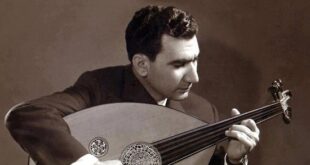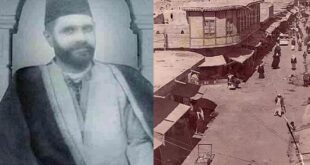د. حيدر عطية كاظم
استطيع أن أدعي، أن مقالاً صحفياً كتبته جريدة “الحاصد”في الثلاثينيات من القرن الماضي نجح في رسم أبعاد الحالة الاقتصادية المزرية التي كان يعيشها الفلاح وعائلته في ظل النظام الإقطاعي عندما قال ما نصه:”يعيش الفلاح مع أطفاله، الذين هم نصف عراة، معيشة ضنكة وهو لا يرتدي سوى العباءة الصوفية، في فصل الشتاء عندما يعود من المزرعة مساءً منهوك القوى، لاعناً الحياة التي حملته أثقالها المنهكة حاملاً على كتفه مسحاته، وهناك تحت خيمة ممزقة يتلاعب بها الهواء والصرصر ويدخل إليها رذاذ الأمطار من جميع جوانبها المفتوحة، جلس بضعة أطفال القرفصاء وبينهم أمهم المسكينة، فينظرون رب البيت الفلاح على طوى، يأتي هذا الفلاح إلى الخيمة وهو مكلوم القلب، فينهض الأطفال برغم البرد القارس ويطلبون كسرة خبز يطردون بها آفة الجوع التي استولت على بطونهم، وحينذاك تنهض الزوجة نهوض المريض من فراشه، فيتعاونان هي وزوجها على تهيئة الساج وعمل كمية قليلة من عجين طحين الذرة والدخن الأسود، فيضرمان النار من قاذورات الأبقار العائد لصاحب المزرعة، ويعملان من ذلك العجين الأسود خبزاً يتناولانه وأطفالهما بشهية زائدة”.
لم يكن غريباً والحالة هذه، أن يدفع هذا الظلم والحيف، فلاحي العمارة لا إلى الهجرة فقط وإنما، يرغبهم في المهن الحقيرة على الزراعة، الحقيقة التي أشار إليها سعد صالح متصرف (محافظ) العمارة في أحد التقارير الذي كتبها في سنة 1944، إذ قال فيه ما نصه:
“الحق إن الحيف الذي يلحق فلاحي العمارة يحبب
لهم الهجرة ويرغبهم في المهن الحقيرة في المدن
على الزراعة، لأن إيراد تلك المهن على نزارته قد
يؤمن احتياجاتهم، ولهذا تكاد لا تخلو مدينة من
مدن العراق ولا عمــل من أعمال الحــكومـة غير
الفنية من عدد عديد من عشائر العمارة، فهم
الجنود المتطوعون، وهم الشرطــة، والعمـال
والخدم”.
صفوة القول، إن إيصال الطبقة الإقطاعية بعض أبنائها إلى منصب الوزارة، وحصولها على نسبة يعتد بها في مجلس الأمة، وهيمنتها على بعض الأحزاب السياسية، في السنوات العشرين الأخيرة من عمر النظام الملكي، قد ساعد على إطلاق يدها في الريف، فراحت تفترس أبناءه بلا حد أدنى للأخلاق أو الرحمة، فأدخل ذلك اليأس والقنوط في نفوس الكثير من الفلاحين، فأطلق أحدهم قريحته ليعبر عن رغبة جامحة بالهروب إلى بغداد، خلاصاً من تلك الحياة، عندما قال والألم يعصر قلبه ما نصه:
“أرد أشرد لبغداد من هاالفلاحة
لا تشبع الجوعان ولا بيها راحة”.
ومما يستحق الملاحظة هنا، أن أولئك الفلاحين الذين دفعهم الفقر المدقع إلى التخلي عن كبريائهم، كانوا قبل عقود قليلة يعتبرون أي عمل آخر مماثل غير حراثة الأرض كارثةً وعاراً ما بعده عار. وفي حالات كثيرة كان رجال العشائر، الذين أجبروا على العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني، يرفضون في نهاية العمل أن يأخذوا مالاً أو أجراً، إذ كانوا يخشون، إذا ما فعلوا، أن يوضعوا في مستوى العمال الأجراء.
إلى جانب ذلك كانت هناك عوامل جاذبة للمدينة، أهمها تأسيس الجيش واستمرار قبول المتطوعين، وظهور الدوائر الأمنية، فضلاً عن تأثير البعض بدعوة أقربائهم وأصدقائهم الذين سبقوهم في الهجرة إلى المدن، وازدياد الحاجة إلى الأيدي العاملة في المدن، خاصة بعد تأسيس “مجلس الإعمار”، وشروعه ببناء العديد من المشاريع.
بدأت الهجرة على شكل أعداد قليلة متسللة من لوائي العمارة والكوت، وبعض الألوية الجنوبية. سكن أولئك المهاجرون، الذين أخذوا يعملون في المهن الوضيعة كحضائر الخيول، في خانات منطقة الفضل، وببدل إيجار شهري قدره 25 فلساً ومع مرور الأيام ازداد وصول الفارين من نار الإقطاعيين إلى مدينة بغداد، لدرجة أن الخانات لم تعد قادرة على استيعابهم، فأخذوا يبنون لهم “مساكن” خاصة بهم في الفراغات الموجودة بين بيوت بغداد وأحيائها والمساحات العامة ولما كان الفلاح المهاجر لا يعرف سوى الصرائف التي اعتاد عليها في حياته السابقة من جهة، وقلة تكاليف موادها من جهة أخرى، فضلاً عن سهولة فتحها وطيها ومن ثم حملها إذا اقتضى الأمر،وعليه فقد أقدم الفلاحون المهاجرون على بناء صرائفهم في بغداد التي لم تختلف عن مثيلاتها في الريف، خاصة في طريقة بنائها ومساحتها التي لم تتجاوز الثلاثين متراً مربعاً في أفضل الأحوال، مع خلوها من الأثاث تقريباً ما عدا صندوقاً يضم ملابسهم، ونادراً ما تحتوي الصرائف على سرير حتى وان كان من سعف النخيل للمنام.
لقد ظهرت أول مجموعة صرائف بالقرب من محطة قطار شرق بغداد، وبمرور الأيام ازدادت الصرائف في تلك المنطقة التي أصبحت تسمى بمحلة الخندق. كان المحظوظ من سكان تلك المنطقة هو من وجد فرصة عمل في أحد المعامل القريبة خاصة معامل السكائر.
كما أدى قبول الجيش للمتطوعين من الفلاحين في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى ظأياً كان الأمر، فإن “أحياء” الصرائف أخذت بالازدياد سنة بعد أخرى، فقد قدر عدد الصرائف في سنة 1940 بثمانية آلاف صريفة تأوي قرابة 40 ألف مهاجر.
أدى الاحتلال البريطاني الثاني للعراق سنة 1941، وتمركز القوات البريطانية في مدن العراق ومنها مدينة بغداد، إلى ظهور الحاجة الماسة للأيدي العاملة لإقامة معسكرات الجنود، وبناء الطرق، وكان ذلك بمثابة عامل مشجع للمظلومين من أبناء الريف بالهجرة إلى بغداد خاصة، فظهرت “أحياء” جديدة من الصرائف أهمها الشاكرية شمال قاعة الخلد بالكرخ التي تقدر مساحتها بـ25كم2 العائدة أصلاً لشاكر الوادي وزير الدفاع. ولما كان شلال المهاجرين مستمر فإن السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية شهدت ظهور منطقة أخرى للصرائف في الوشاش شمال مدينة المنصور الحالية.
وفي الوقت نفسه (1943) ظهرت واحدة من أهم أحياء الصرائف في مدينة بغداد ألا وهي منطقة “العاصمة” الواقعة شرق سدة ناظم باشا وتحديداً في المنطقة التي يشغلها مستشفى الجملة العصبية(حالياً) وجنوبه حتى بغداد الجديدة والتي تقدر مساحتها بـ15كم2 وكان بناؤها العشوائي وغير المنظم لا يختلف عن بقية أحياء الصرائف الأخرى، وكان جل سكان هذه المنطقة هم من العاملين في معامل الطابوق الواقعة شرق تلك المنطقة في مكان ليس بعيداً عن قناة الجيش الحالية(.
ومما يجدر ذكره هنا، إن موظفي الدوائر الرسمية أطلقوا على منطقة العاصمة أسم “خلف السدة”،وكانت تتصل بالرصافة من ثلاث جهات رئيسية، جهة باب الشيخ، وجهة ساحة الطيران، فضلاً عن جهة القصر الأبيض. وغدت هذه المنطقة بعد اكتضاضها بالمهاجرين خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما تلاها محلات متلاصقة بعضها مع البعض، كل محلة سكنها أبناء عشيرة واحدة تقريبا لكن مع ذلك علينا أن نسجل هنا، أن أولئك المهاجرين ولئن تحرروا نسبياً من بعض القيود العشائرية، فإنهم أقاموا علاقاتهم مع بعضهم ومع العشائر الأخرى على أساس النظم والتقاليد العشائرية.
إن الحديث عن صرائف منطقة “العاصمة” لا يتكمل إلا بالحديث عن “شطيط” (النزيزة) وهو عبارة عن نهير صغير لا يتجاوز عرضه المترين، كان يحاذي أسفل الجانب الشرقي من السدة مباشرة، ليمتد حتى مصب نهر ديالى، وكانت صرائف “العاصمة” واقعة على الضفة الشرقية لذلك النهير، الذي وجد أساساً لتخفيف الضغط على السدة في أوقات الفيضانات، وتحول مع مرور الأيام إلى نهر تصرف إليه المياه الثقيلة لأحياء باب الشيخ والبتاوين وبقية أحياء الرصافة، وكان عبارة عن مستنقع دائم للمياه الآسنة، وزاده سوءاً اتخاذه بعض أبناء تلك الصرائف مرتعاً لجاموسهم. ولم نبالغ إذا ما قلنا إن البعض من أطفال تلك المنطقة اتخذه “مسبحاً”.
إلى شمال منطقة “العاصمة” ظهر تجمع آخر وكبير للصرائف والذي عرف بمنطقة “الميزرة” الواقعة شرق مجزرة الشيخ معروف، وقد بلغت مساحة هذه المنطقة، التي تشغلها حالياً كراجات ساحة النهضة والتي كانت بالأساس مقابر لليهود، بحوالي 10كم2.
عن رسالة (الموقف الرسمي والشعبي من سكان الاكواخ في بغداد)
اقرأ ايضا
نص نادر: سامراء في سنة 1911.. ماذا يرى اليوم في سامراء
كاظم الدجيليإذا أتيت سامراء وأطلقت فيها طائر نظرك لا يكاد يقف على عامر قديم العهد …