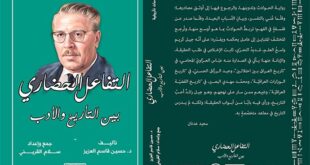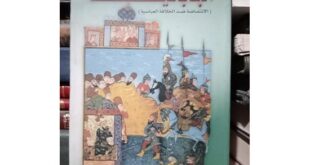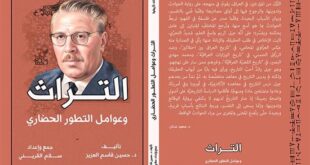د. حســين الهنـــداوي
الفلسفة كانت اللحظة الأدفأ في النقاش مع الشاعر الراحل بلند الحيدري كلما سنحت فرصة حديث معه، وهي كانت دائماً، مناسبات مبهجة وتلقائية وبعيدة عن الجدية المتصنعة.
كانت أحاديث عالية الود والعمق والعفوية تنعقد أو تنفرط دون تعمد، وتناثرت بين لقائنا الأول في 1988 وبين رحيله المباغت في ٩ آب (أغسطس) 1996. الأول منها كان قبل، وخاصة بعد، ندوة فكرية لي في ديوان الكوفة بلندن نحو منتصف عام 1988 حول “هيغل والفلسفة الاسلامية” أدارها باقتدار عال الشاعر والناقد الكبير الدكتور صلاح نيازي أمام مستمعين لم يبلغ عددهم العشرين من محبي الفلسفة كان حضورهم حدثا بذاته، ولم يكن بلند الحيدري ومحمد مكية ورفعة الجادرجي وصلاح فائق وكاظم الخليفة وكنعان مكية واحمد المهنا ويسري حسين ومي غصوب وسعدي عبد اللطيف وأحمد ناهد إلا من ظل في الذاكرة منهم. هيبة الحضور زادها ألقاً عمق وتخصصية الاستفهامات وروح التواضع التي أثيرت على هامش تلك المحاولة التي حاولت خلالها إبراز مركزية فكرة الحرية باعتبارها جوهر الفلسفة الهيغلية مفندا مجمل الصياغات والعقائد الجامدة السائدة في الثقافة العربية المعاصرة حولها ولحد الآن غالباً.
شدّني بلند منذ الوهلة الأولى بأدبه الجم مثلما أدهشني بمعرفته الطيبة بفلسفة هيغل وبعاطفته حيال ذلك الفيلسوف الألماني المتوفي قبل أكثر من قرن ونصف القرن آنئذٍ، والمجهول عمليا بل بالأحرى المشوه السمعة في ثقافتنا المأخوذة بقوة لا سيما آنذاك بفكرة ملتبسة، نشرها بعض الايديولوجيين المتمركسين عنه، مفادها أن هيغل هو محض مفكر مثالي برجوازي وحتى رجعي، زاعمين مع بعض الغرور أيضاً أن الماركسية أعادت الى الهيغلية مجدها الوحيد، الديالكتيك، عندما جعلته “يمشي على قدميه بعد أن كان يمشي على رأسه” عند هيغل كما خيّل لهم.
والحال، برأينا، لا يمكن بأي شكل مقارنة عبقرية وأصالة مفهوم الديالكتيك الهيغلي، مع نسخته المؤدلجة وبالتالي الميكانيكية التي صاغها واعتنقها عقائديون ماركسيون من شتى التيارات، ليس كارل ماركس بينهم في كل الأحوال. فثمة تواصل حميم بل تكامل بين الجدلين الماركسي والهيغلي لا يدركه الأيديولوجيون الذين لم يلمسوا أيضاً وجود تواصل وتكامل بين “الأيديولوجية الألمانية” و”رأس المال”، أي بين أول وآخر مؤلفات ماركس نفسه.
تلك الانطباعات المشتركة الأولى، سترافق أحاديثنا اللاحقة كلما تعلق الأمر بالفلسفة لتجعل اللقاء مع بلند الحيدري لحظة ممتعة لي بذاتها، زاد من أهميتها ان الشاعر الراحل كان يبادر، كما مع سواي، الى ايصال انطباعاته النقدية والتشجيعية عن مقالات لي تعنى بالفلسفة دأبت مجلة “الاغتراب الادبي” اللندنية الرائدة على نشرها آنذاك، مستفهماً أو ناقداً أو مشككاً بأفكار أو مشكلات تضمنتها حول قضايا “الحرية” و”الاستبداد الشرقي” و”موت الفن” و “الصراع بين الوظيفي والجمالي في فن العمارة”، و “بين الذات الفردية والذات الجماعية في الشعر والفن عامة”. كما بدا لي أن الفلسفة هي السبب العميق ربما في حذره غير المعلن لكن القديم تجاه الدوغمائيات كافة.
هذا الانجذاب الى الفلسفة لم يكن طارئاً أو سطحياً لديه. إذ يخبرنا بلند أنه قرأ، في فترات شتى، نصوصاً لجان بول سارتر وألبير كامو وهيغل ونيتشه، وإن بعضها يمثل الأرضية الفلسفية لهذا العمل الشعري أو ذاك من أعماله الأكثر تميزاً.
وهذا هو ببساطة منبع فكرة هذه المقالة عن “بلند الحيدري وجاذبية الفلسفة” التي ولدت أصلاً لتكون بمثابة تحية أو هدية خاصة للشاعر في ذكرى ميلاده السبعين إلا أنه باغتنا بالرحيل قبلها ببضعة أيام. لكن التعهد بدا شاق الانجاز الامين في الوقت المرتجى. والآن وبعد سنوات كثر على رحيله، يظل تأثير الفلسفة الغربية والفلسفة عموماً في شعره، وفي الشعر العربي الحديث إجمالاً، بانتظار من يتفرغ لدراسته تفرغاً أكثر منهجية وشمولا. فهذه المقالة محاولة أولى عن هذا الموضوع وإن هي طمحت في الأصل أن تفي بوعد لم يعد من الشهود عليه أحد، بعد وفاة بلند ورفيقة عمره الفنانة التشكيلية دلال المفتي، سوى الوفاء.
ينبغي التأكيد من الآن، وقبل كل شيء، على أن الفلسفة لدى هذا الشاعر كانت محض غرض شعري وجمالي الأصول دائماً وليس توجها معرفياً ممنهجاً ودقيقاً. فهو استفاد منها بالشكل الذي شاء وفهمها بالطريقة التي بدت له موائمة أو ممتعة. أما مراحل احتكاكه بأفكار فلسفية غربية أو أخرى فهي برأينا ثلاث، الأولى منها غير مباشرة تماما ويعبر عنها روحها البودليري المحض كما في ديوانه الأول “خفقة الطين” (1946) خاصة وقصائد في مجموعات لاحقة.
المرحلة الثانية تنبض بروح وجودية وتوحي باستفادة مباشرة أو شبه مباشرة من نصوص لجان بول سارتر أو ألبير كامو المتأثرين جداً بهيغل بداهة. وتندرج في هذا الإطار الوجودي، المتمركس بحذر بين حين وحين، معظم قصائد مجموعاته “أغاني المدينة الميتة” (١٩٥١) و”جئتم مع الفجر” (١٩٦١) و”خطوات في الغربة” (1965) وحتى “رحلة الحروف الصفر” (1968).
أما الثالثة فهي مرحلة تأثير نصوص هيغلية محضة في شعر بلند الحيدري كخيار فكري/ جمالي واع ومعلن وخلاق بذاته وهي تتماهى مع مرحلة النضج العليا من شعره إذا جاز القول وخاصة في مجموعتيه “حوار عبر الأبعاد الثلاثة” (1972) و”أغاني الحارس المتعب” (1973).
- المرحلة البودليرية وتجاوز رومانسية أبو شبكة
لم يتردد الشاعر العراقي بلند الحيدري من إخبارنا مراراً بأنه تأثر في شبابه بالتيار البودليري في الشعر العربي ممثلاً خاصة بمحمود حسن إسماعيل والياس أبو شبكة وعمر أبو ريشة وسعيد عقل الى جانب الإعجاب المبكر بقصائد شعراء المهجر النابضة بوجدانية حارة وذاتية،وعواطف رومانسية جيّاشة بالمرارة والغربة والضياع والمنفى، والدائرة حول موضوعات “فلسفية” مجردة وغامضة كالحياة والفناء والروح والخلود والزمان والعدم وهو ما ميّز قصائد “همس الجنون” لميخائيل نعيمة خاصة وكانت عامل شهرته السريعة.
والحال إن هؤلاء جميعاً هم جسر ثورة الحداثة النوعية التي أدت الى تطور الشعر العربي الحديث لاحقاً على يد بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي ومحمود البريكان وأيضاً حسين مردان، كل في مجاله وفي خضم مخاض معقد تماماً كمخاض الثورة التي جرت داخل الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر وأدت إلى ظهور تيار الحداثة فيه على يد بودلير ورامبو وفيرلين ولوتريامون ومالارميه فيما لعب ورد زورث وكوليردج وشللي وكيتس وبيرون الدور نفسه في الشعر الانكليزي.
وفي تأكيد على الأبعاد التلقائية والعاطفية لروح تلك الحقبة المقترنة بالأزمات العالمية الكبرى والاستفهامات الكونية والهزات الشاملة والتمردات العميقة، يرد هذا النصّ على لسان بلند الحيدري:
“هنالك في بغداد الأمس كان الواحد منّا يحاول أن يجد لما تراكم في نفسه من قلق وهلع وخيبة متسعاً في الأدب يثبت فيه قيماً جديدة تتناسب مع أحاسيسه وتفهمه العاطفي لمشاكل العالم. كان العالم يتحدث بصوت مبحوح عن جريمة قتل مرعبة حدثت في هيروشيما، وعن انتحار كاتب ألماني في البرازيل، وعن طالب بعث برسالة إلي الرئيس الأميركي يسأله عما إذا كان عليه أن يتمّ دراسته بعد أن اخترعت القنبلة الذرية. وكانت صحف بغداد تتحدث عن تاجر خلط الدقيق بنشارة الخشب وقدّم خليطه خبزاً للناس… كانت تحملنا قصاصات من ورق عبر أمسيات كثيرة من مقهى إلي مقهى، لنستمع إلى هذه المحاولة الجديدة، وننتقد تلك القصيدة ونحن نحاول أن نفلسف العالم من حولنا. وظلّ البعض منّا يحاول يائساً أن يوفق بين ماركس ونيتشه لينتشل نفسه من صراع مر”.
وبلند الحيدري مولود في 26/9/1926 لعائلة كردية ميسورة تقطن ما بين أربيل والسليمانية إذ كان والده ضابطاً في الجيش العراقي فيما والدته هي فاطمة بنت إبراهيم أفندي الحيدري الذي كان يشتغل منصب شيخ الإسلام في إسطنبول. لكن الثابت أن بلند، ويعني “شامخ” باللغة الكردية، والذي لم يشأ إكمال دراسته الثانوية آنذاك، كان كثير القراءة في شبابه للنصوص الأدبية والفكرية المترجمة المتوفرة ثم صار معجباً أشد الإعجاب بالشاعر الفرنسي شارل بودلير والشاعرين السوري عمر أبو ريشة واللبناني الياس ابو شبكة بل حاول في الاربعينيات استلهامهم في شخصيته كما أبدع بعض القصائد الرومانسية العمودية في تلك السنوات مما يجعله سلفاً من أوائل المجددين في بنية القصيدة العمودية في العراق باتجاه الرومانسية الأصلية.
ويمكن المقارنة، كما فعل نقاد عديدون، بين قصيدة (سميراميس) لبلند الحيدري وقصيدة (شمشون) لإلياس أبو شبكة للتأكد من وجود تشابه كبير بين القصيدتين في الروح والمضامين والشكل، والاستنتاج على أساس ذلكأن بلند استلهم شعر أبي شبكة فعلاً. ففي قصيدة بلند تلك تبدو الملكة الآشورية سميراميس أقرب الى “دليلة” في قصيدة “شمشون” لإلياس أبو شبكة، أي كرمز لسعار الجمال والفتنة الجسدية والشهوة واللذة والهمس المحموم المقترن بالغدر والخيانة والنذالة في أجواء مسرح درامي مثير لقصور وعروش ومضاجع وتيجان وسطوة جوفاء ودماء وخطيئة وحيث تكون النهاية بالاسئلة العبثية ذاتها. بيد أن الإقرار بتأثر بلند بأجواء وحتى مشاعر قصيدة ابي شبكة تلك الى درجة توظيف وزنها الخفيف وقافيتها الرائية المكسورة لا ينفي واقع أنه انطلق من هواجس أولى منبعها بعض ما وقع بين يديه من قصائد مجموعة بودلير الشهيرة “أزهار الشر”.
فالنزعة القوية الى الدرامية الرومانسية والى كسر جاهزية الكلمات والعروض والموسيقى الداخلية، والميل الجامح الى إعلاء مشاعر الوحدة والصمت تؤكد هاجس بلند المبكر نحو “الاستقلالية الشعرية” كما نحو وضع بصمته العراقية الخاصة على تلك القصيدة وكل قصائد مجموعته الأولى “خفقة الطين” ما جعل مارون عبود يقول “ليس فينا من قدر الصمت، واستوحاه.. كما استوحاه هذا الشاعر، وقل في الأدب العربي من أوحت إليه الطريق ما أوحت إلى بلند الحيدري”.
وعلى العموم نعتقد، ان مقارنة جمالية عميقة بين قصيدتي “شمشون” و”سميراميس” وشفافيتهما وحتى ابطالهما، ينبغي أن تقود الى الاستنتاج بان بلند يبدو أكثر انتماء للرومانسية من أبي شبكة نفسه. فهناك مسافة تزيد على عقد من الزمان بين تاريخ نشر القصيدتين، بيد أن ثمة تباين واضح بينهما في نوع اللغة الرومانسية ذاتها ومنذ البيت الاول. أي بين قول الياس أبو شبكة:
ملّقيه بحسنكِ المأجورِ.. وادفعيه للانتقام الكبيرِ..
وقول بلند الحيدري:
سكر الليل باللظى المخمور.. واقشعرت معالم الديجور
وهناك أيضا التباين الخفي وأكاد أقول التضاد بين الأرضية الثقافية وربما السياسية بين القصيدتين. فبينما تأسست قصيدة الياس أبو شبكة على شخصية شمشون الأسطورية المستدعاة من التراث التوراتي، تأسست قصيدة بلند الحيدري على شخصية سميراميس الأسطورية المستدعاة من التراث الآشوري العراقي ما يمنحها بعداً إضافياً لم يهتم به النقاد. و”سميراميس” هو الاسم الاغريقي للملكة الآشورية (سمورات) وهي شخصية حقيقية بابلية الأصل عاشت في القرن التاسع قبل الميلاد. نفس الاستنتاج يصدق عند المقارنة بين قصيدة (موت شاعر) لبلند الحيدري التي مطلعها:
أسلم الرأس لكفيه خذولاً
وتمطت بازدراء شفتاه
خفقت بسمته دنيا أسى
كنهار شرب الغيم سناه
وقصيدة (مصرع الفنان) التي كتبها الشاعر السوري عمر أبو ريشة ومطلعها:
نــام عــــن كــأســــــه وعــــــن أحـبـابـــــــــــه
قــبــــــل أن يـنـقـضـــــي نـهــــــار شــبــابـــــهْ
نــام عــــن سـكــــــرة الــحـــيــــاة وقــد جـــفّ
شـــــــراب الـــسُــــلـوان فــــــي أكـــــوابـــــه
بــســـمـاتُ الـــرضـــا عـــلـــــى شــفـتــيـــــه
وشــــــتـاتُ الـــرؤى عـــلـــــى أهــــدابـــــه
فيما لمح آخرون أن في قصيدته (الصمت الحالم) ظلال قصيدة (المساء) لإيليا أبو ماضي، ومنها ” لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد”، مستشهدين بقول بلند الحيدري:
كفّي التألم واهجعي
تعب الزمان ولن يعي
عبثاً ترومين الصباح.. وصبح سعدك قد نعي..
عيناك باهتتان في لجج الظلام المفزعِ
وفي الواقع، إن مقارنات وتلميحات باهتة كهذه، والتي رددها بعض النقاد المتعجلين، تبدو قسرية نظراً الى أنها تستهدف غالباً، لسبب أو آخر، إغفال أصالة وديناميكية الطاقة الشعرية لهذا الشاعر في تلك المرحلة التاريخية المتزامنة مع أجواء صدمة الحرب العالمية الثانية التي استمرت لسنوات وشهدت مصرع الملايين منتصف اربعينيات القرن الماضي حيث كانت مشاعر فقدان الأمل تسود العالم لا سيما العالم العربي الذي خرج إنسانه محبطاً سياسياً وعاطفياً وهو ما عبر عنه الشعراء والفنانون بتيارات وحركات متمردة، رومانسية وماركسية أو وجودية أبرزها شعراء المهجر وجماعة أبولو وغيرهم الذين عبر كتاباتهم الخاصة وعبر ترجمة النصوص الأدبية الأوروبية الى علي محمود طه، وإبراهيم ناجي وأبي شبكة على وجه العربية، ساهموا في انبثاق تيار رومانسي في المنطقة والعراق عبر عنه عدد من القصائد المهمن نشرت في الجرائد العراقية والمجلات العربية، وبعضها نشرت خارج العراق، منها أهم قصائد (أزهار ذابلة) للسياب، و (عاشقة الليل) لنازك الملائكة وأيضاً قصائد ديوان بلند الحيدري الأول (خفقة الطين) الذي كان بمثابة إعلان عن ولادة شاعر كبير لم ينف يوماً استفادته ليس من سابقيه وحسب بل من معاصريه أيضاً، موضحاً في محاضرة له: “في تلك الفترة نشأنا بالقرب من تجربة الجواهري، والياس أبي شبكة، وعمر أبي ريشة، ومحمود حسن إسماعيل.. وكذلك تجربة شعراء المهجر، ولا سيما إيليا أبو ماضي ونسيم عريضة. وكنا نحاول أن نلتقي ونفترق في آن واحد.. لأن العصر كان يمر بمنعطف، وهذا المنعطف كان يجمع ويفرق في آن واحد.. وإذا كنتم تسألونني عن المضمون، فإنه بلا شك هو الذي يغير الشكل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المضمون تجديداً تقدمياً.. ما نقوله نحن في التجديد في الشكل قد لا يكون تقدمياً، ولكن ثمة مضامين فرضت تغييراً في الأشكال “..
صفوة القول، ومثل غيره من رواد حركة الشعر العربي الحديث المعاصرين له، فإن شعر بلند عبّر عن الشعور بالخيبة الذي اكتنف العصر الحديث في فتر ة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما عبّر عن ذلك الشاعر البريطاني وديزموند ستيوارت الذي ترجم أشعار بلند الحيدري الى الإنكليزية في عام 1950.