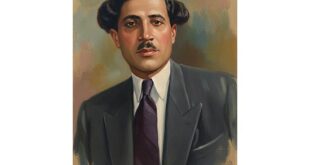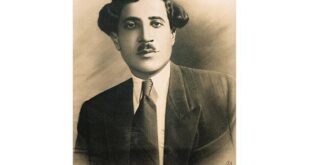ترجمة : محمد المعصراني
لم يُعالج البديع عند العرب في القرن التاسع إلاّ مرةً واحدةً وذلك في مؤلفٍ دانيماركيٍّ. وها قد مضى أكثر من خمسٍ وأربعين سنةً على نشر الأستاذ المساعد في كوبنهاغن آ. ميرين أثره الكبير الأول (البلاغة عند العرب)[32] دون أن نستطيع حتى الآن أن نورد ذكر أثرٍ آخر مماثلٍ له حقًّا. إن ميرين لم يستطع إعطاء صورةٍ عن التطور التأريخي لهذه البلاغة وكل المصادر التي اعتمد عليها في كتابه تعود إلى عصر انحطاط العلم العربي ولم يكن الوقت قد حان آنذاك لحل أي مسألةٍ من المسائل المتصلة بنشوء البلاغة والبديع وبالعصر الذي نشأ فيه. ثم جاءت السنوات الأخيرة فحملت معها شيئًا جديدًا، وأدّت الدراسة النظرية للبديع عمومًا إلى نشوء مدرستين في روسيا: الأولى مدرسة الكساندر فيسيلوفسكي التي تنحو منحًى تأريخيًّا، والأخرى مدرسة آ. آ. بوتيبني التي هي أقرب إلى المنحى اللغوي السيكولوجي. وقد ألقت مؤلفات كوينغ، التي سار فيها على طريقةٍ جديدةٍ، الضوء على البديع في التوراة[33] وأعطى ريكيندورف تحليلًا لبعض الألفاظ المجازية في اللغات السامية[34].
وقد حاول أحد علماء العرب أخيرًا أن يتتبع تأريخ تطور النقد الأدبي عند العرب في خطوطه العامة[35]. ثم إن المؤلفات التي تعتمد على التركيب من نوع الكتاب الذي يتمتع بشهرةٍ عالميةٍ نعني كتاب لارسون (Hans Larsson) “La logique de la poésie” (باريس 1909) تُبين بمزيدٍ من الجلاء مقدار تقدمنا عمّا في زمان ميرين في آرائنا النظرية. وإلى جانب المؤلفات النظرية الواسعة ظهرت في الشرق موادُّ جديدةٌ في البديع العربي ولكن كثيرًا مما نشر هناك لم يستعمل الطريقة الانتقادية. ولهذا فليس عندنا حتى الآن، باستثناء كتاب ميرين، نصٌّ واحدٌ من هذا النوع عولج بروحٍ انتقاديةٍ، ومع ذلك فإن هذه المواد الجديدة تسمح لنا بأن نقول – على سبيل الإشارة وإنْ لم يكن بالأمر النهائي – بوجود بعض الخطوط العامة في تأريخ نشوء البديع العربي وتأريخ العصر الذي نشأ فيه. وذلك هو هدفي الوحيد من حديثي هذا.
عُرِفَتْ في الأدب العالمي ثلاثة صروحٍ كبيرةٍ من البديع، جميعها أصيل، وجميعها يستحق أن يُسمى بالكلاسيكي لما كان له من تأثيرٍ في دائرته الخاصة[36] وقد أشرنا إليها في طيات البحث.
وبالنظر إلى هذا الانتشار وهذا النفوذ تكتسب مسألة أصالته أهميةً خاصةً: هل نشأ حقًّا في دائرة لغته أم أنه انعكاسٌ من الانعكاسات العديدة للبديع الأرسططالي الكثيرة؟ إنه سؤالٌ يُسأَل بحقٍّ. فنحن نعرف جيدًا أي تأثيرٍ خطيرٍ كان للعِلم اليوناني في الحضارة العربية بمجموعها وخصوصًا في أوائل القرن التاسع. وكان السريانيون الوسطاء في ذلك في معظم الأحوال. ونعرف أن قواعد اللغة السريانية كلها والبلاغة السريانية كلها ترتقي بتمامها تقريبًا إلى أرسططاليس. ومعلومٌ أن بعض العلماء الألمان استطاعوا في العقود الأخيرة أن يكتشفوا آثارًا للنفوذ اليوناني اللاتيني في نظرية الصرف والنحو العربيين[37] وليس بين هذا والبديع إلاّ خطوةٌ واحدةٌ طبعًا. ولعل الهند أيضًا فضلًا عن اليونان يجب أن ندخلها في دائرة استقصائنا. فقد تسرَّب إلى الأدب العربي بوساطة الأدب الفارسي كثيرٌ من المواضيع الأدبية الهندية، وكان للطب الهندي كثيرٌ من الأنصار في بلاط خلفاء بغداد. ونعرف أسماء بعض الأطباء الهنود الذين انتقلوا إلى العاصمة بفضل البرامكة. ومع كل ذلك يجب أن ننفي تأثير الهند في البديع العربي. فنحن لا نستطيع تقرير الأطر الزمانية كما أن القليل مما وصل إلينا من الأقوال التي تُعزى إلى الهنود في مجالي البلاغة والبديع يَترتَّب علينا حتى الآن أن ننكر صحته[38].
أما التأثير اليوناني فأجدر بالبحث. ومع أن هذه المسألة شديدة التعقّد إلاّ أن شرحها أكثر إمكانًا بكثيرٍ لأن لدينا في هذه الناحية موادَّ أوسعَ. وسنرى في ما يلي أن النتيجة هنا مماثلةٌ. فالبديع اليوناني لم يؤثّر مباشرةً في نشوء البديع العربي وتطوره.
إن تأثير أرسططاليس في العلم العربي معروفٌ جيدًا ولا يمكن أيضًا أن ننكر أن بيانه وبديعه ومعانيه قد تُرجِمَتْ إلى اللغة العربية في عصورٍ مبكرةٍ. قد يكون ثمة خلافٌ كبيرٌ في تعيين التواريخ الدقيقة أو أسماء المترجمين ولكن مما لا شك فيه أن ترجماتٍ عربيةً لهذه المؤلفات قد وجِدَتْ في القرن العاشر[39] ولكننا لا نستطيع أن نجد في المؤلفات العربية التي تتناول البديع أي أثرٍ لآراء أرسطو. فهذه المؤلفات تختلف جدًّا عن مؤلفات الفيلسوف اليوناني معنًى ومبنًى. وخير مثالٍ يُساق هنا لتعزيز هذا الرأي الكاتب الشهير الجاحظ (ت255هـ – 869م)، فقد كان الجاحظ يعرف أرسطو خيرَ معرفةٍ وكان يُسمّيه بأبي المنطق ويذكره كثيرًا في مؤلفاته خصوصًا في كتاب الحيوان[40]، ولكن (أبا المنطق) هذا لا يُذكر مطلقًا تقريبًا إلاّ حجةً في علم الحيوان، لأن جميع أقواله استقيت من كتابه عن الحيوانات، بل يمكن الشك في مبلغ معرفة الجاحظ بسائر مؤلفات أرسطو[41]، لسنا نستطيع حتى الآن أن نقطع هذا الشك ولكننا نستطيع التأكيد بأن أرسطو لم يترك أي أثرٍ في تطور تحليل الإبداع الشعري عند العرب. ولم يكن بديع أرسطو إلاّ حادثةً طارئةً في تأريخ البديع العربي. ولَعلَّ هذا يبدو لأول وهلةٍ غريبًا بعض الشيء لما نعرفه عن منزلة أرسطو العظيمة عند العرب. ولكن هذا الاستغراب يزول عندما نعلم يقينًا أن قرّاءه وشرّاحه كانوا جميعًا تقريبًا من الفلاسفة أو المُتبحِّرين بالعلوم الطبيعية. أما الباحثون في نظرية الأدب وتأريخه، وهم دائمًا اللغويون في أضيق معاني هذه الكلمة، فقد كانوا يتحاشون الخوض في ذلك. وإذا سرنا شوطًا أبعد في تتبع تأريخ بديع أرسطو عند العرب وجدنا شارحين شهيرين له هما ابن سينا وابن رشد. ومن المشكوك فيه أن يكون الأخير قد فهم فهمًا صحيحًا بديع أرسطو، ففي نقله الطليق لهذا البديع عَرَّف التراجيديا بأنها فن المديح والكوميديا (فن التقريع) وعلى هذا الأساس تصبح القصائد العربية في المديح تراجيديات والهجاء كوميديا[42]. فإذا كان حتى الفلاسفة قد فهموا بديع أرسطو هذا الفهم فلا عجب أن رأينا الباحثين في نظرية الأدب ينفرون في كثير من الأحيان من البديع اليوناني. فهذا الجاحظ مثلًا يأتي على ذكر منطق أرسطو أحيانًا ولكن بشيء من سخريةٍ خفيةٍ فهو يقول: «ألا ترى أن كتاب المنطق الذي قد وسِمَ بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب لما فهموا أكثره»[43] (ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطق… ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه)[44]. ويذهب أبعد من ذلك النظري المعروف ابن الأثير أخو المؤرخ الشهير. فهو يقول عن ابن سينا بسخريةٍ لاذعةٍ [45]: «فإن ادّعيت أنّ هؤلاء تعلّموا ذلك من كتب علماء اليونان قلت لك في الجواب هذا باطلٌ بي أنا فإني لم أعلم شيئًا مما ذكره حكماء اليونان ولا عرفته… ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكلام إلى شيءٍ ذُكِرَ لأبي عليّ بن سينا في الخطابة والشعر وذكر ضربًا من ضروب الشعر اليوناني يُسمّى اللاغوذيا وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي عليٍّ ووقفني على ما ذكره فلمّا وقفت عليه استجهلته فإنه طَوَّل فيه وعَرَّض كأنه يخاطب بعض اليونان وكل الذي ذكره لغوٌ لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئًا».
اقرأ ايضا
أفاعي إلياس أبو شبكة وأزهار بودلير
نمر سعديإلياس أبو شبكة شاعِرٌ رومانسيٌّ مبدع وأَدِيبٌ ومترجم لبنانِي كبير، ولد في 3 مايو …