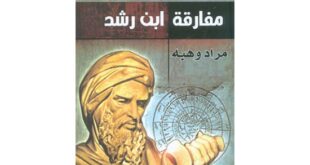علي سفر
قد يبدو غريباً للبعض أن تستدعي الذكرى المئوية لميلاد المفكر والمناضل المناهض للاستعمار فرانز فانون التفاتة واهتماماً في زمنٍ انسحبت فيه أفكاره، لا لأنها قد بَلِيَت، بل لأن ثمة تراجعاً في العناوين الكبرى للمواجهة مع الكولونيالية، أمام جماهير تحوّلت اهتماماتها بعيداً عن التفكير في مصائرها الوطنية، بعد غرقها في يوميّاتها المُلحّة.
لكن الاستغراق في الواقع المحلي لا بد أن يُعيدنا إلى نقطة تلتقي فيها تحليلات فانون مع الرؤى العميقة التي تدرس أحوال الناس، وتستكشف أثر السياسات الاستعمارية تاريخياً على واقعهم الراهن. ومن هذا المنظور يمكن إدراك سرّ هذا الحضور المستمر لفانون، رغم عمره القصير، وإنتاجه المدون القليل نسبياً.
الاحتفاء بمئوية ميلاد فانون، ووفق الأجندة العالمية المُسخَّرة لهذه المناسبة، انطلقت فعالياته منذ الشهر الثاني من هذا العام، وستستمر حتى نهايته. فقد أُقيم مؤتمر دولي في كلية الطب بجامعة سوسة التونسية، كما أُقيمت فعاليات متعددة في وطنه جزر المارتينيك، ويَلفت الانتباه منها مؤتمر مسخَّر للذكرى يُقام هذه الأيام في جزر الأنتيل، يحمل عنوان كتابه “معذَّبو الأرض”، ويُكرِّم إرث فانون بثلاثية تضامنية تشمل شعوب هايتي، والكاناك (كاليدونيا الجديدة)، والشعب الفلسطيني، ضمن مشروع فكري يرفع صوت التضامن العابر للقارات.
وُلد فرانز فانون في العشرين من يوليو/تموز عام 1925 في المارتينيك، وغادرها عام 1943 ليقاتل في صفوف قوات فرنسا الحرة ضد النازية. درس الطب النفسي في مدينة ليون بين عامي 1947 و1951، ثم عمل في مستشفى البليدة بالجزائر عام 1953، حيث انخرط سريعاً في الثورة الجزائرية. تُوفي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول عام 1961، ولمّا يبلغ السادسة والثلاثين من عمره.
أصدر فانون كتابين أساسيين، هما: “بشرة سوداء، أقنعة بيضاء” (1952)، الذي كشف فيه عن تشوّه الهوية لدى المستعمَرين تحت سطوة الاستعمار الثقافي والاغتراب، إذ يُرغَم الإنسان على النظر إلى نفسه بعين الآخر، فيكفّ عن أن يكون هو. تحدّث عن “الأسود الذي يرى نفسه من خلال الأبيض”، وعن الداخل الذي صار مسكوناً بالخارج، وعن اللغة التي فقدت براءتها وصارت وسيلةً للاستلاب. لم يكن الكتاب دراسة أكاديمية، بل توضيحاً مهمّاً بأن الاستعمار لا يحتل الأرض فقط، بل يحتل الوعي. وأن الجلوس إلى طاولة واحدة مع المستعمِر ليس فعل نُضج، أو مكسباً يُفتخر به، بل هو أحياناً قناعٌ أبيض لبشرة سوداء ممزَّقة.
والكتاب الثاني هو “معذَّبو الأرض” (1961)، الذي أصدره في خضمّ الثورة الجزائرية، ويُعدّ من أبرز أعمال الفكر السياسي في القرن العشرين. قدّم فيه تشريحاً جريئاً للعنف الثوري بوصفه أداةً للتحرر الوطني. في هذا النص، لم يُدافع فانون عن العنف باعتباره غريزة، بل بوصفه فعلاً ضرورياً في مواجهة عنفٍ بنيوي يمارسه الاستعمار. فالاستعمار، كما قال، لا يفهم إلا لغةً واحدة: القوة. لكن العنف عند فانون لم يكن هدفاً، بل وسيلة لتحرير الإنسان من حالة دونية مفروضة، ولتحقيق ولادة جديدة. من دون هذه الولادة، تبقى الشعوب رهينة الاستعمار، حتى لو انسحب المستعمِر عسكرياً. ولهذا كان فانون واضحاً في تحذيره من الاستقلالات الكاذبة، ومن النخب التي تخلف الاستعمار لتعيد إنتاجه بثياب وطنية. في هذا الكتاب، ذهب فانون نحو موقف واضح ضد ما رآه قادماً: النخب الوطنية التي تعيش على هامش الاقتصاد الكولونيالي.
لا يمكن حصر فانون في تعريفٍ واحد. فقد كان طبيباً نفسياً، ومناضلاً سياسياً، ومثقفاً متمرّداً، وكاتباً ساخطاً، وشاهداً على العنف الاستعماري بأبشع صوره. واختار، وهو في الثلاثين من عمره، أن ينحاز بكل وعيه وجسده إلى الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وأن يتحوّل من محلّلٍ للمرض النفسي الذي يصنعه القهر، إلى مشارك في محاولة علاجه بالنار والدم.
ما يجعل فانون حاضراً اليوم ليس فقط نضاله، بل فكره الذي تشكّل على المتراس. فلا يزال يُقرأ في عالمٍ لم يُنهِ استعمارَه، بل أعاد إنتاجه بأقنعة أكثر حداثة، وبصمتٍ أكثر ضجيجاً. حيث تُستعاد نظرياته في سياقات متعددة: في نضال السود بأميركا ضد العنصرية البنيوية، وفي نقد النيوليبرالية التي تُعيد إنتاج التبعية الاقتصادية والثقافية، وفي محاولات بناء خطاب ثقافي جديد خارج المركز الأوروبي. وأيضاً في مساءلة “الدولة الوطنية” التي فشلت في تحرير الإنسان.
ومن هذه النقطة يمكن استحضار فكره في نقد التجارب التي خاضتها الدول المتحررة من الاستعمار، وقراءة العطب البنيوي الذي أصابها منذ مرحلة ما قبل الاستقلال. إذ يمكن إسقاط المسار العام للثورة الجزائرية التي سلكت طريق العنف المسلح نحو الحرية، مقارنة باستقلال الكونغو الذي تحقق عبر مفاوضات رسّخت حضور المستعمر في جسد الدولة الجديدة من خلال إعادة بناء الحياة على إيقاع الهيمنة، بعد تحوّلها من حضور عسكري مباشر إلى حضور ثقافي واقتصادي.
هذه التحليلات، حين تُسقط على واقع البلاد التي لا تزال حتى اليوم تعاني فشلاً في بناء مشاريعها الوطنية، تطرح سؤالاً حول ما تم رسمه لها منذ مرحلة السيطرة الاستعمارية. والأمر لا يتعلق بنظريات مؤامرة، بل بسياق من العلاقة التبادلية، يرى فيها أصحاب القوة ضرورة استمرارها ما دامت تخدم مصالحهم، وهو ما يتوافق مع مصالح الفئات المحلية المستفيدة من الواقع المفروض بقوة المستعمرين.
وحين تلجأ الثورات إلى العنف المضاد من أجل التحرر، تُعاد صياغة المصالح مع المنتصرين الجدد، الذين يضمنون استمرار سيطرتهم باسم إرثهم النضالي. وهكذا، تقمع القوى السياسية المعارضة باسم “الثورة”، ويتحوّل حضور السلطة الديكتاتورية إلى قوة احتلال جديدة تُعيد إنتاج القمع باسم التحرر، فيصبح النضال مركّباً، يحتاج إلى أدوات تتطور بالتوازي مع تطور أدوات القمع نفسها.
حدث هذا مراراً، في تجارب متعددة، خصوصاً في العالم العربي، ولا سيّما في التجربة السورية، حيث لا تزال تحليلات فانون تحتفظ براهنيتها، خصوصاً تلك التي وردت في كتاب “معذَّبو الأرض”. فقد كتب فيه ما يشبه البيان النقدي ضد “البرجوازية الوطنية” التي تتسلم السلطة بعد الاستقلال في كثير من الدول الأفريقية والآسيوية، لكنها تفتقر إلى القوة الاقتصادية والإبداع الثقافي، فتتحوّل إلى وسيط تابع، تعيش على فتات الشركات الأجنبية. إنها “طبقة تستهلك ولا تُنتج، وتُقلّد المستعمِر ولا تتحرّر منه”، تستعير اللغة والذوق والنموذج من المستعمِر، ثم تزعم بناء الأمة. و”بعد الاستقلال، يتحوّل القصر الرئاسي إلى نسخة مشوّهة عن مقرّ الحاكم العام، ويتحوّل الاستقلال إلى استمرار للهيمنة بوسائل أخرى”. وفي نهاية المطاف، “هؤلاء الذين ادّعوا تمثيل الشعب، يتحوّلون إلى أوصياء عليه”.
ومن أجل ألّا يبقى المستعمِر حاضراً إلى الأبد، يقترح فانون بديلاً عن هذا الواقع البائس: ثورة شاملة تطاول البنى الاقتصادية والثقافية والسياسية، وبناء اقتصاد مستقل فعلياً لا يعتمد على رأس المال الأجنبي، وانبثاق نخبة جديدة متجذّرة في الأرض والشعب، لا نخبة ناطقة بلسان المستعمِر. الثورة عند فانون لا تكتمل بالعلم والنشيد، بل بإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والأرض، بين الشعب واللغة، بين الهوية والمستقبل. وهي ثورة تبدأ في النفس، كما تبدأ في السياسة.
ومن اللافت أن الذكرى المئوية للثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي، التي بدأت في 21 يوليو/تموز 1925، تتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد فانون. هذا الاقتران يمنح مساحة إضافية للتأمل في زمن مقاومة الاستعمار، والسير نحو الاستقلال، ومراجعة المشاريع الكبرى التي اشتغلت عليها النخب السياسية آنذاك، وهي تستعد لتأسيس الدولة الوطنية.
في سبعينيات القرن الماضي، كان كتاب “معذَّبو الأرض” يُدرَّس، ولو من خلال فصول مختارة، في المناهج الدراسية السورية. لكن مع تغير المناهج والتوجهات الرسمية، أُقصي من الصفوف المدرسية، وبقيت الترجمة الرائعة التي أنجزها الراحلان سامي الدروبي وجمال الأتاسي (1966) معروضة بكثافة في معارض الكتب وعلى أرصفة الجامعات. لكنّ الحضور الأكبر لفانون لم يأت من الكتب، بل من الواقع نفسه. واقعٌ لا يختلف كثيراً عن المعطيات التي كتب عنها.
· عن العربي الجديد
اقرأ ايضا
مراد وهبة.. (فيلسوف) الأجيال
د. أنور مغيثأراد المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة أن يشتبك فى غماره مع كل القضايا …