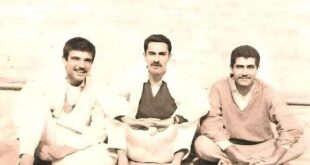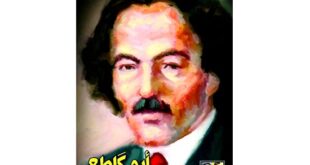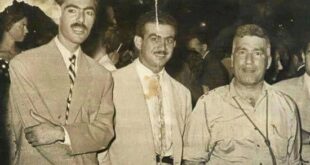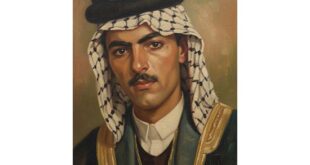مؤيد آل صوينت
تشكل التساؤلات المتدفقة وتحاقلها المستمر في سبر أقاليم المعرفة حاضنة أساسية من حواضن الكشف عن آفاق تبدو متساوقة من ناحية الصدور والنظر، الأمر الذي ما انفكت المراجعات المنهجية تنظر إليه بمنظار الاحترام والتبجيل، ثمة مواضيع تأخذ بريقها من عدة أصحابها المعرفية وأخرى تسجل في مبرزات التكوين لولوجها عوالم تعد في أحايين كثيرة مناطق غير ذات بال لمن سبق له التعاطي مع تلك الموضوعات, رغم المراجعات والدراسات التي اصطبغت بميسم الاجترار والترداد وإطلالة السبعة التبجيلية في التثاقف مع منجز لا يعد في النظر الفاحص سوی مؤمثلات سبق للآخر أن قدم محاولات كشف وإظهار هجست بنزعة دوغمائية سجلت الظاهرة الأبرز في الطروحات الأكاديمية المعتادة.
قد يتبادر للذهن لأول وهلة، أن الأمر يتعلق بمكونات مفهوم (سؤال اللغة): العناصر والعلاقات ومبادئ التنظيم، تمثل العناصر الجنبة البنيوية للغة، أما العلاقات فتظهر الطبيعة الوظائفية لها، فيما تنهض القواعد النحوية بحمولات مبادئ التنظيم، انطلاقاً من هذه التوصيفات، تبدو اللغة فاعلاً يفرض على الفكر جملة من الحدود المتساوقة تارة والمختلفة تارة أخرى، وضبطاً لقيم ذاتية تلج في تخوم التحديدات لتغدو عنصراً قاراً فيها، هذه الدقة التمييزية في التوصيف تتسابق كغلالة تفترش مدونات شيخنا الأستاذ لتظهر من تلافيف نسجها ترصيعات المعرفة، وثريا العلم.
هذا التعالق يدفعنا إلى التأكيد أن الاتصال اللغوي مع تكوينه البنيوي وسمته الوظائفية لم يكن إقصاء وطلاقاً بين المتلازمات، بل كان تطوراً وانفتاحاً لها، الأمر الذي حمل شيخنا الأستاذ (أبو جناح) إلى القيام بدراسات هي من اللغة في الصميم بضميمة الاستعمال، بمعنى أن اللغة تحولت مع الاستعمال إلى لغة نحوية – وظائفية، ولغة فكرية – استعمالية، من غير أن يؤدي هذا الاستلال إلى انمحاقها كما ظن البعض، بل أدى إلى الكشف عن أبعادها الجديدة والمتجددة، رائية في سؤال اللغة البعد المفتوح المثوّر للعقل والمنظم للمعرفة اللغوية المترامية الأطراف، ولا يختلف منطق القضايا اللغوية على مختلف تفصلها عن هذا المنحى الرابط دوما بين الذهنيات والتعيّنات أو بين التصور وما يفترض أن يكون واقعا، فالمعادلة ذاتها قائمة في متن مكتوب أو ملفوظ شفاهي، غاية الأمر، أن المعيار في هذا هو السبيل الزمني لا غير.
ومن المعروف أن سؤال اللغة إذا احتك بسؤال العقل أدى إلى سؤال الدلالة لا محالة، لذا، تظهر تحديدات شيخنا الأستاذ بمثابة الرصد لمسارات التشكلات اللسانية على اختلاف توجهاتها، ويمكن أن يُستشفّ من خلالها التمخضات الفكرية التي واكبت تطور مدلولاتها، إذ تداخل المعرفي باللغوي وأصبح فضّ الاشتباك بينهما ضرباً من المحاولة غير محمودة النتائج، فلا يمكن تحديد مرجعية واضحة فضلاً عن تخصيص حيز واضح المسارات وتخوم كل مفهوم على حدة.
وإذا كان حديثنا ينعقد حول بنية الجدل الخلاق في مدونات شيخنا الأستاذ، فإن من أهم خصائصه البنيوية أن قيمة كل عنصر بما فيه لا يتحدد إلا في ضوء قواعد النظام الذي تنتمي إليه، من هنا نستطيع أن نطرح فرضيتنا المتمثلة في أن سؤال اللغة عند (أبو جناح) يقوم على مدى الانسجام والانصهار بين التمثلات المعرفية التي تتجسد متداخلة أحياناً ومتوازية أحياناً أخرى، هذه التمثلات تعد البنية الكلية لهذا الجدل اللغوي الخلاق، ولعل مفهوم النسق والنسق المضمر، سواء في صورته، أو في عناصره الجزئية المتمثلة في نسق الاستقصاء – نسق الشمول – نسق التساؤل – نسق المثاقفة – نسق الإحاطة- نسق التحول – لعل هذا ما يشكل المفاهيم الكلية الذي طبعت منجز شيخنا الأستاذ منذ مدوناته الأولى. فضلاً عن هذا، فإن النظر الفاحص لمدونته قادنا إلى الوقوف عند بنى أصلية وطارئة في مجمل الحمولات التي طرحها، ففي إطار البنية الأصلية تظهر تشكلات المعرفة اللغوية الأولى وآفاق تمثلها ممهورة باشتراطات وضوابط تقف عند تخومها من غير الولوج إلى عوالم افتراضية لا محدد لها، أما البنية الطارئة فيجليها النقد الدائم للنماذج التمثيلية التي تخضع الملفوظ إلى جدلية الافتراض والقاعدة، بما يؤدي إلى الفصل بين الصيغ والوظائف، وأتاح هذا الضبط الدقيق المسكون بهاجس الإفادة – أقول – أتاح لشيخنا الأستاذ التقرب كثيراً من فكرة الائتلاف الكلامي، الأمر الذي لم تحفل به التمثلات الافتراضية ولا تعده معياراً للتمخض ضمن إطار الدقة والتحري والأمانة ليتحلى الالتباس في الخطاب النحوي واضحاً في القسم الموجود بين التصور الواقعي والمنحى التأليفي الذي يسوّره داخل المنظومة اللسانية العربية الموروثة.
انطلاقا من المعطيات السابقة، يبدو (سؤال اللغة) سؤالاً حاضراً عند (د صاحب ابو جناح) في مجمل مدونته الكتابية والشفاهية المختزنة ضمن أسارها مجموعة من الكتب والبحوث المتشحة بوشاح التعاطي مع التراث اللغوي تارة، والتحاور مع الجلبة الحضارية تارة أخرى، وعلى الرغم من تسييق سؤال اللغة في المتن (الصاحبي) إلا أنه ظل الهاجس المستمر المنبجس الذي تعاطى معه على امتداد مسيرتها المعرفية المتسابقة. وهنا يطل التساؤل الآتي: ما المكونات التي شاركت في تشكيل التوجيه المعرفي لدى شيخنا الأستاذ؟ والينابيع التي حفرت مسارات جريانها في أخاديد منجزه ؟ للإجابة عن هذا التساؤل يمكن رصد مجموعة من المصبات، يمكن تحديدها وفقاً الآتي:
مثّل (سيبويه) ومدونته المدهشة (الكتاب) ينبوع التأسيس الأول في التشكّل اللغوي عند شيخنا الأستاذ وتعاطيه مع اللغة بجانبها الفعلي الاستعمالي لا الافتراضي المصنوع، وهو الأمر الذي ما فتئت مدونة (شيخ النحاة) تأكيده والإصرار عليه، وهو ما يتجلى في إيراد (سيبوبه) لمفردة (الكلام) على حساب الملفوظ (الجملة) وهو المصطلح الذي اتسعت مديات استعماله في المدونات اللغوية بعد صاحب الكتاب، لاسيما المتأخرة منها، وتبدو تصورات (شيخ النحاة) حاضرة في معظم المنجزات المعرفية لشيخنا الأستاذ، بل حتى في تحايثه مع اللغة بروافدها الاستعمالية التي ما انفكت تأن تحت وطأة الاشتراطات والقيود القسرية المسلطة عليها من قبل معظم النحاة الذين أعقبوا سيبويه بعد إنجازه مدونته الخالدة، هذا التأكيد على البعد الاستعمالي للغة يتبدى سمة بارزة من سمات شيخنا الأستاذ لنصوص العربية، سواء المتون الواصفة للتكوينات اللغوية أم النصوص الشارحة لها، أما التمفصلات الافتراضية فلا يحتفي بها كثيرًا، لابتعادها عن القيمة التنجيزية وإيغالها في البعد الفيزيقي الذي جعل من المنوال النحوي عصياً على التمثل والامتصاص.وتظهر في أعطاف مدونات شيخنا الأستاذ تلك الرؤية التي تصور (الكتاب) على أنه منجز مثاقفة بين الخليل وتلميذه النابه، فالتطلعات الدقيقة لسيبويه وظفها الخليل وشيدها بإجابات ومراجعات اصطبغت بالصبغة العلمية الواثقة والهادفة إلى إخضاع الظاهرة اللغوية لاشتراطات منزوع منها الطابع الإعلامي كما هو ديدن شيخ النحاة وأستاذه العظيم. ويتبدى هذا التصور في معظم المحاورات والتعليقات التي أوردها شيخنا الأستاذ والطروحات التي تناولها براعه، ففي حين يلجأ معظم من رقنوا إلى الشروح وشرح الشروح، يركن أستاذنا إلى مدونة شيخ النحاة باحثاً فيها عن الأصول المعرفية المهيكلة لظاهرة ما، أو ترجيح رأي على آخر بعيداً عن هاجس التقليد والاجترار الذي يسور قواعد النحو العربي، التوجه الذي حفز على النزعة الاستعمالية للغة وأدخلها مدخل النحو الافتراضي بما يذهب برونقه وأبعاده التواصلية.
وشيّد (ابن جني) النسق المضمر الثاني المشكل الآفاق الفكر اللغوي لدى شيخنا الأستاذ، ولما كانت العبارة اللسانية، في جوهرها، بحثاً عن الدلالات، فهي تصطدم بمعطى أساسي: لا يستطيع الإنسان التعبير إلا عما تسمح له اللغة بالتعبير عنه، ومع استحضار المكتسبات الثقافية والمضمون التواصلي لذاكرتها، يصبح بالإمكان النزوع نحو ثيمات خلاقة ومناويل راكزة للتعاطي معها. وفقاً لهذا التصور، لم يكن (ابن جني) مجرد عالم ضمن جمهرة من العلماء ضبطت المعرفة اللغوية العربية بمساطر نقدية قل مثيلها، ويبدو أن التشكل الثقافي لابن جني وفرادته أثار إعجاب شيخنا الأستاذ وأخذ منه المأخذ الذي ينبجس في معظم منجزه، فالقراءة الفاحصة لأعطاف مدونته تكشف عن مجسات التلقي الشمولية، ومغزى التعالق بينهما، يتمظهر من مقولات (ابن جني) في التأويل وتبنيه لقراءات مختلفة تتميز بسمة الفرادة فيما يتعلق بالطروحات اللغوية التي سبقته، فضلا عن تلقيه النص بهاجس التساؤل لا التقبل المنزوع عنه صيغة المراجعة والمحاورة. ومنذ بداية التشكل المعرفي لشيخنا الأستاذ، مثل ابن جني النسق المضمر الذي ما انفكت قراءته وآفاق تمثله تؤسس لثقافة استمدها من فواتح فضاءات اتسمت بطبيعة التعامل مع النصوص بتوصيفها نصوصاً مفتوحة قابلة للمثاقفة والتفريع، الأمر الذي وظفه شيخنا الأستاذ في معظم أعماله، ولو شئنا أن نقدم دليلاً على دعوانا لوجدناه جلياً فيما كتبه أستاذنا عن ابن جني ومقارنته بما رقته عن (المبرد)، فالنزعة الاجترارية التي طبعت (تفكير المبرد) سجل عليها شيخنا الأستاذ نقداً علمياً هادئاً لمثل هذه التوجهات التي أثقلت المدونة اللغوية باشتراطات أبعد ما تكون عن طبيعة البحث اللغوي، وجعلت النحو ينوء بأعباء ما كانت لتوجد لولا هذه النزعة الافتراضية التي هيمنت على الدرس النحوي لقرون طوال بحمولات أبعد ما تكون عن الاستعمالات الفعلية التي نشدها سيبويه وأستاذه قبل أن تتحول إلى مجموعة من المقننات البعيدة عن القيمة التنجيزية للملفوظ ووظيفته في التواصل والبلاغ، وهي القيمة التي تكاد تكون السمة الأبرز في مجمل أعمال ابن جني، وتبدو مقولات التأويل والقراءة المفككة لأنساق الثقافة المشكلة القواعد النحوية هي الجنبة الأكثر استشرافاً في تعاطي شيخنا الأستاذ مع التراث اللغوي العربي وآفاق تمظهره، هذا التمظهر المستند إلى التحاور مع نصوص صيغت في أزمنة متفاوتة اقتضت طبيعة الحقول المنضوية تحتها أن تكون متفاعلة وفق السياقات والأعراف المائزة بين تشكل وآخر. وفضلاً عن التحاقل العلمي بين ابن جني وشيخنا الأستاذ، تبرز سمة مشتركة على الجانب الشخصي بينهما، تتبلور في الطلب المستمر للمعرفة وملاحقتها اينما وجدت، ولسنا بحاجة إلى التذكير بموقف (أبي على الفارسي) مع ابن جني ومقولته الشهيرة له، المقولة التي حدت بابن جني على أن يلازم الفارسي لأكثر من أربعين عامًا، وهذه السمة أظهر ما تكون عند شيخنا الأستاذ عبر ملاحقته لكل ما يستجد على صعيد التحصيل وتمثله للمعرفة الحديثة تمثلاً متشبعاً بالحرص على قراءته وتلقيه، الأمر الذي عانيت منه – شخصياً- ، فكان إن تكرم أستاذنا علي بكتاب من خزانته أجد لزاماً أن أقرأه لئلا أُحرج عندما يسألني عن أفكار مبثوثة فيه.
أما ثالثة الأثافي لدى (أبو جناح) فهو الأستاذ إبراهيم مصطفى، الباحث الذي انطبعت مراجعاته النقدية للتصورات اللغوية الموروثة في ذهن شيخنا الأستاذ بتلازم يكاد يشاكل مقولة اللفظ والمعنى إذا جاز لنا أن نستعير مثل هذا التوصيف، مثّل إبراهيم مصطفى الظاهرة الأبرز للنظر النقدي المنعتق من بوتقة التقليد وهاجس التقادم، ليسجل علامة فارقة في الدرس الإحيائي عبر مراجعاته المستمرة لمقولات النحاة واشتراطات وضع القواعد وتقنينها، الأمر الذي نمّ عن جرأة لم يسبق لها مثيل في التربيض النقدي للمدونة النحوية، منذ بداية تشكلها، وسحبها إلى تخوم التدوين، هذا الأنموذج في التثاقف مع الآراء بعيدًا عن جلباب القداسة المكتسبة من التاريخ، مثل أقليما تعاطى معه شيخنا الأستاذ في معظم محاوراته الشفاهية والكتابية، ومحاولة نزع القداسة واليقين في أحكام وآراء اكتسبت مردوديتها المعرفية بالقدم ليس إلا، أما عند تفكيك أنساقها وفحص التمظهرات المبثوثة في أعطافها، فتظهر مدى التناقض والاضطراب المتناسل لقواعد أبعدت اللغة عن مجالها الأهم: التفاعل والاتصال، قد يكون إبراهيم مصطفى الأيقونة الملقية بظلالها على كثير من الدارسين في جوانب جزئية أو انتقائية، لكنه مثّل عند شيخنا الأستاذ -فيما أتصور – الأنموذج المحتذى به للمراجعة المستمرة للمفاهيم والتصورات والمقولات التي اكتسبت طابع الأحكام القارة، لتسجل اشتراطاتها على المتون النحوية اللاحقة لها، فالتفسير الذي يصنف حركات الإعراب وتبويب خانات الموقعية وتشارطها مع أساليب العربية في التعبير نلفيه مبثوثاً في معظم الأبحاث المدونة من قبل شيخنا الأستاذ لمراجعة الجهاز المفاهيمي النحوي وآليات اشتغاله، سواء ما يندرج تحت عنوان التيسير، أو ما يمكن تضمينه تحت حقول أخرى، لاسيما حقل الافتراض العلاماتي وزجه في توصيف مقولات محددة المفارق للتأصيل النظري الحامل لندوب الممارسة الافتراضية، وهو ما تعج به المدونات النحوية العربية بعد سيبويه، ويبدو موضوع الأساليب الموضوع الأثير لدى شيخنا الأستاذ، وصداه المتفرع عن الاهتزاز الذي حركه إبراهيم مصطفى في بحيرة النحو العربي الراكدة، ولعل دعوى أستاذنا المستمرة إلى قراءة المدونة اللغوية بعيدًا عن الافتراض الذي أثقلها بتفسيرات وفهوم وقصود وتعليلات هي أبعد ما تكون عن الممارسات اللغوية الصرفة، لعل هذه الدعوى تشكل العمود الفقري لتحرير الممارسة اللغوية من كل ما علق بها وإرجاعها إلى الصبغة الوظيفية وقصدها الاتصالي المنتج القواعد تضبط إيقاعها من غير أن تدخل نشازاً في لحن وجودها.