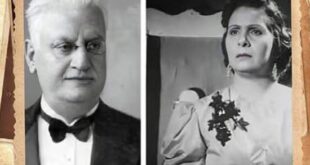أيمن جزيني
على مثال صباحات لبنانيّة حزينة استيقظت بيروت في خريفها على موت إسكندر حبش، الشاعر والمترجم والصحافيّ الثقافيّ بعد صراع مع مرض السرطان. وكأنّه أكمل الجملة التي ظلّ يكتبها طوال حياته: “نتأخّر في الحياة… لنصل في الوقت الخطأ”. بين الشعر والترجمة والصحافة، عاش الراحل تجربةً ثقافيّةً تُشبه قصيدةً طويلة في انتظار نهايتها، حيث يتقاطع الوعي بالموت مع رغبةٍ لا تنطفئ في أن يُقال ما لا يُقال.
كان حبش، المولود في بيروت عام 1963 من عائلةٍ فلسطينيّة الأصل، أحد أبرز الأصوات التي جمعت بين الكتابة والترجمة والوعي الوجوديّ، وأحد الذين جعلوا من اللغة بيتاً لا سقف له. عُرف بصوته الهادئ، وكتابته البطيئة، وترجماته التي تحمل حسّ الشعر حتّى في النثر.
لم يكن يكتب ليُفاجئ، بل ليُصغي. في زمنٍ يزداد فيه ضجيج القول، اختار الصمت طريقاً للمعنى، والبطء شكلاً للحضور. هل يمكن أن نفهم موته إلّا بوصفه استمراراً لذلك الصمت الذي حمله في كلماته منذ بداياته الأولى؟
ولادةٌ على حافة الحرب
وُلد إسكندر حبش في بيروت، المدينة التي عرفت في السبعينيّات الحرب إيقاعاً يوميّاً، وتعلّمت أن تكتب شعرها من الركام. في تلك البيئة الممزّقة، بدأ حبش يدوّن خوفه بالقصيدة. قال في أحد حواراته: “الكتابة بدأت مع القذائف، مع الخوف، كأنّها عزاءٌ في مواجهة الخراب”.
تخرّج في الجامعة اللبنانية، وعمل منذ شبابه في الصحافة الثقافيّة، تحديداً في جريدة “السفير”، “صوت الذين لا صوت لهم”، حيث تولّى قسمها الثقافيّ لسنوات طويلة. هناك، صار اسمه مرادفاً للهمس بهدوء لا للصراخ والضجيج. كان يكتب بصمتٍ وبلغةٍ تمشي نحو الغياب. لكن خلف الصحافي الهادئ كان يعيش شاعرٌ مقلق، يكتب ضدّ العالم، لا ليتحدّاه بل ليفهم هشاشته. كان يعرف أنّ الشعر ليس زينة اللغة، بل طريقةٌ لمساءلة الوجود.
لم يكن حبش يترجم نصوصاً فحسب، بل يترجم وجوداً. يلمس في كلّ عملٍ حياةً أخرى، يعيد ولادتها بالعربيّة كما لو كانت قصيدته الخاصّة.
الشّعر لغة الصّمت والانتظار
تشكّل تجربة إسكندر حبش الشعريّة مشهداً فريداً في الشعر اللبنانيّ الحديث. منذ ديوانه الأوّل “بورتريه رجل من معدن” (1988)، مروراً بـ”نصف تفّاحة” (1993) و”تلك المدن” (1997)، وصولاً إلى “لا شيء أكثر من هذا الثلج” (2013) و”نتأخّر في الحياة” (2023)، تتكرّر فكرة واحدة: اللغة لا تُقال لتملأ الفراغ، بل لتشير إليه. في شعره، يحتلّ الصمت موقع اللغة نفسها. القصيدة عنده ليست محاولةً لقول كلّ شيء، بل تمرينٌ على الإصغاء.
كتب إسكندر حبش في أحد نصوصه: “أنحاز إلى الشعر الذي يغلّفه الصمت، إلى الجملة التي تُبقي الباب موارباً، كأنّها لا تريد أن تنتهي”. بدت قصيدته، على الدوام، وكأنّها تنسج من الهواء نسيجاً هشّاً للذات، حيث الكلمة تسعى إلى أن تكون صدى، لا إعلاناً.
ليس صدفةً أن يميل حبش إلى العناوين التي توحي بالغياب: الثلج، المدن، التأخّر، الغياب، النهاية. كلمات تقيم في هامش الزمن، وتتعامل مع الحياة كما يتعامل الرسّام مع الضوء الأخير قبل الغروب.
اللّغة منفى داخليّ
ليست اللغة عند إسكندر حبش أداةً للتعبير، بل مكانٌ للعيش. في شعره وترجماته على السواء، تُصبح الكلمة بيتاً هشّاً يسكنه المنفيّ. قال في إحدى مقابلاته: “الترجمة طريقة أخرى للكتابة، ومنفى آخر نحاول من خلاله أن نُعيد تعريف أنفسنا”.
لذلك بدت الترجمة عنده امتداداً للشعر، وليست فعلاً تقنيّاً. كان يرى فيها عبوراً بين لغتين، بين حياتين، بين وجودين. ترجم عن الفرنسيّة والإنكليزيّة أعمالاً كبرى تركت بصمتها على المكتبة العربية، منها: “لست ذا شأن” للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، “ألف منزل للحلم والرعب” لعتيق رحيمي، “العاشرة والنصف ليلاً في الصيف” لمارغريت دوراس، “نجهل الوجه الذي سيختتمه الموت” من الشعر الإيطالي المعاصر، و”مورفين” لميخائيل بولغاكوف.
ليست اللغة عند إسكندر حبش أداةً للتعبير، بل مكانٌ للعيش. في شعره وترجماته على السواء، تُصبح الكلمة بيتاً هشّاً يسكنه المنفيّ
لم يكن حبش يترجم نصوصاً فحسب، بل يترجم وجوداً. يلمس في كلّ عملٍ حياةً أخرى، يعيد ولادتها بالعربيّة كما لو كانت قصيدته الخاصّة. الترجمة عنده ليست نقلاً من لغة إلى أخرى، بل عبور من ذاتٍ إلى ذات.
الكتابة الصّحافيّة سرعة.. والشّعر تذكير بالتّأخّر
ثلاثة عقود قضاها إسكندر حبش في جريدة “السفير” جعلت منه شاهداً على التحوّلات الثقافيّة العربيّة. كان يرى في الصحافة سيفاً ذا حدّين: تُتيح لك أن تكتب كلّ يوم، لكنّها تسرق من عمرك ما لا يُستردّ. كتب ذات مرّة: “الصحافة تعلّمني أن أكون سريعاً، لكنّ الشعر يذكّرني أن أتأخّر”.
ذلك التناقض بين السرعة والبطء، بين العجلة والانتظار، بين ضوضاء الجريدة وصمت القصيدة، هو ما شكّل شخصيّته الأدبيّة. حين أُغلقت جريدة “السفير” في نهاية 2016، شعر كما لو أنّه فقد صوته الأوّل، لكنّه اكتشف في الصمت المتروك فرصةً جديدةً للكتابة الحرّة.
الموت كتجربةٍ شعريّة
لم يكن الموت عند إسكندر حبش نهايةً، بل حالةُ تفكّر دائمة. في ترجمته لمختارات الشعر الإيطاليّ تحت عنوان “نجهل الوجه الذي سيختتمه الموت”، بدا كأنّه يكتب نبوءته الشعريّة الخاصّة.
في ديوانه الأخير “الأرض حين لن أكون هنا” (2024)، يُعلن الشاعر مصالحةً غريبةً مع الغياب، وكأنّه يهيّئ نفسه ليكون “هناك” لا “هنا”. كتب: “الأرض ستمشي وحدها، حين لن أكون هنا”. لم يكن هذا استعارة وحسب، بل إدراك شعريّ عميق بأنّ الموت ليس انقطاعاً، بل استمرارٌ في شكلٍ آخر من الصمت. عاش حياته كمن يكتب وداعه على مراحل، بلا نواحٍ ولا تمجيد، بل بتأمّلٍ طويل في معنى العدم.
وُلد إسكندر حبش في بيروت، المدينة التي عرفت في السبعينيّات الحرب إيقاعاً يوميّاً، وتعلّمت أن تكتب شعرها من الركام
كان يعي، عن حقّ، أنّ الكتابة هي الوجه الآخر للموت: كلاهما يطلب عزلةً مطلقةً، ويعتمد على الصمت لبلوغ المعنى. لذلك حين جاء رحيله، بدا طبيعيّاً، كخاتمةٍ منسجمةٍ مع نصّه الطويل في الانتظار.
توالت عبر صفحات “فيسبوك” كلمات الرثاء التي تنعاه، وتعدِّد جهوده في الشعر والترجمة والصحافة الثقافيّة، ومنها كلمة للشاعر العراقيّ أسعد الجبوري الذي صُدم، وقال: “الصاعقة تتمادى، الآن، فتحرقُ أجمل الأشجار في غابة اللغة… الأخ الشاعر المترجم إسكندر حبش يتحرّر من آلامه بالذهاب إلى فضاءات ما بعد الموت، مَنْ غير الكلمات ستمشي خلفك حِداداً يا صديقي؟”.
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …