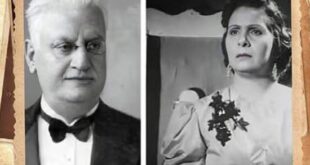عبده وازن
رحل الشاعر اسكندر حبش عن 62 سنة، أمضى الردح الأكبر منها في الكتابة والترجمة والسهر والترحال بحثاً عن زهرة الشعر. وفي أشهر مواجهة المرض الذي سماه “السيد س” كتب اسكندر قصائد ويوميات فيها من الألم ما فيها من الشجاعة والقوة. وفي إحدى قصائده يقول:”لا نفع بعد في أن تحصي ما تبقى من ساعات”. ويقول في إحدى اليوميات أيضاً: “كل شيء تفكك في جسدي. كل شيء يذوي، يموت، وأنا على سريري أنتظر. وعلي أن أتقبل ذلك».
جيل شارع الحمراء
يمكن إدراج اسم إسكندر حبش ضمن مجموعة من الشعراء الشبان، حضروا، في أواخر التسعينيات، بعضهم جاء للتو من وراء المتاريس اليسارية ومن شوارع الحرب الأهلية أو غير الأهلية، وبعضهم الآخر عاش مناخ الحرب من قرب، في ما كان يسمى بيروت الغربية. لكنهم جميعاً جعلوا من شارع الحمرا ومقاهيه وحاناته، مركزا للشعر والعيش والسهر، وتوزعوا بين «شي أندره» و»الويمبي» و»جدل بيزنطي» وسواهما. كان هؤلاء الشعراء بدأوا في تأسيس جيل جديد ومختلف، نظراً إلى صعودهم من أنقاض الحرب التي اختبروها وكتبوها واعتمدوا معجمها وعبروا عن واقعها اليومي وآثارها. لكنهم ما لبثوا أن تبعثروا تاركين وراءهم طابعهم الجماعي الذي لم يألفه كثيراً الشعر اللبناني سابقاً، وأكثر ما يميزه خروجه إلى عالم الشعر الواقعي، الحاد والأليف في آن واحد، وكذلك إلى فضاء اللغة «المضادة» والأنتي – فصاحة وبلاغة، قصداً، والقريبة من الحياة اليومية.
سعى إسكندر حبش إلى الترجمة من الفرنسية فأمدته الترجمة بما يمكن تسميته مقاربة شعرية خاصة ميزته منذ ديوانه الأول “بورتريه لرجل من معدن” (1988). إلا أن تمارين الترجمة استحالت إلى أفعال ترجمة مذ شرع إسكندر حبش في نشرها سواء ضمن صحيفة “السفير” حيث يعمل كمحرر ثقافي أم في بعض المجلات والكراريس أو الكتيبات التي دأب على نشرها. وبدا أثر الشعر الفرنسي والأوروبي والعالمي بيناً في قصائده التي توالت من ثم، وضمتها مجموعات مثل “نصف تفاحة” (1993) و”نقطة من ليل” (1998) و”تلك المدن” (1998). لكن قارئ إسكندر حبش كان يحس أن الشاعر هو في حال من البحث الدائم، وأن تجربته الشعرية ولغته تسعيان إلى مزيد من التبلور، على أن هذا الإحساس لم يعن أن إسكندر حبش لم يستطع إنجاز قصائد خاصة به أو كتابة شعر جميل وحميم، أو مساءلة الأشكال والأساليب الشعرية المختلفة.
شكوى الخريف
ولعل ديوانه «اشكو الخريف» الذي صدر عام 2003 بعدما كان توقف عن نشر الشعر زهاء خمسة أعوام، مؤثراً الترجمة والكتابة النقدية، بدا بمثابة ثمرة هذا الانقطاع أو الصمت. فالديوان قصيدة طويلة تمثل من غير شك ذروة عالم إسكندر حبش، وربما أوج صنيعه الشعري، ليس لأنها قصيدة طويلة وذات نفس رثائي فحسب، وإنما لأنها أيضاً قصيدة مبنية ومصنوعة أو مصهورة، ولكن في منأى عن أي افتعال أو تكلف لغوي أو شعري.
«أشكو الخريف” قصيدة طويلة هي أشبه بالمرثية التي لا تتوجه إلى شخص ما، مقدار ما تنطلق من الذات (الراثي) إلى الذات (المرثي). وهذه العلاقة الملتبسة يؤكدها المقطع الأخير من القصيدة الطويلة حين يخاطب الراثي (الشاعر) المرثي (الشاعر نفسه أيضاً) قائلاً: “أكان عليك/وأنت الغريب عن هاتين اليدين/أن تكتب؟”. غير أن القصيدة التي تستوحي ملحمة جلجامش السومرية لم تقترب من البنية الملحمية ولم تسع إلى توظيف الأسطورة توظيفاً جاهزاً وهادفاً، بل كانت نوعاً من الكتابة على هامش الأسطورة، كأن تتخطى أشراك الشعر الأسطوري الذي سطع نجمه خلال الخمسينيات وأصبح – حينذاك – أشبه بالنزعة الرائجة.
لا يهتم إسكندر حبش بما سمي سابقاً إسقاطاً للأسطورة على الواقع، في ما يعني الإسقاط من استعادة لرمزية الماضي وطليعية البطل في كل تجلياته، المأسوية أو التموزية. وهو أصلاً لم يشر إلى توظيفه أسطورة جلجامش في قصيدته، ولولا اسم أنكيدو الذي يتكرر أكثر من مرة والجو الذي يشي بعالم الملحمة السومرية، لما أدرك القارئ أنه إزاء نص مشرع على الأسطوري، فالشعر يكتب حكاية جلجامش وأنكيدو كتابة حميمية، إذا أمكن القول، معتمداً النفس الرثائي الحزين و”الخريفي” بحسب ما يوحي العنوان. شاء توحيد صوته في صوت جلجامش ليرثي صديقه أنكيدو الذي لن يكون إلا هو نفسه في الختام.
مونولوغ شعري
وقد يكون من الممكن قراءة القصيدة في ذاتها بعيداً من منبتها الأسطوري، وحينئذ تضحى القصيدة أشبه بـ»المونولوغ» الشعري الجميل المتفاوت بين النفس الرثائي والنزعة الغنائية الهادئة والترميز والاعتراف والتأمل… تصبح القصيدة أيضاً أشبه بالسيرة التي تضمر تفاصيلها وأحداثها وتلمح إلى بعض معالمها كرحلة من الموت إلى الموت، وقد تلوح عبر هذه السيرة بعض الرموز (كالسواحل والأعداء والمعسكرات) وبعض الوجوه أو الأطياف (الغرباء) وبعض الأحوال التي طالما خالجت الشاعر: النسيان والتعب والغربة والشيخوخة واليأس والهرب، والموت أو الرحيل…
في هذا الديوان يبدو أن الشعر بات يفترض البحث والتجريب، وشاعرنا ليس غريباً عن التيار التجريبي وتحمل قصائده دلالات واضحة عن المأزق الذي يتخبط الشعر فيه قسراً. والمأزق ليس إلا وجهاً من وجوه الكتابة، إذ هو حافز على التخطي والاختبار. ولا يخفي الشاعر إحساسه المأسوي العميق حيال “الورقة البيضاء”، فيطمئن نفسه أنه سيفقد “النطق”، وسيدع روحه “تلملم الحكم”. فالشعر حال من الاختباء وما وظيفة الشاعر إلا الكشف عن الخباء والمخبأ. وليس من قبيل الصدفة فقط أن يجمع الشاعر في هذا الديوان، بين اختباء امرأته واختباء القصيدة.
كثافات روحية
لا يخلو هذا الديوان من مادة شعرية كثيفة ومكثفة. فهو ينم عن كثافات روحية وأحوال وأوصاف وصور وأحاسيس وألوان. لكن اللغة هنا لا ترغب كثيراً في الإفصاح عما يعتريها ويخالجها والشاعر لا يكتمل إلا عبر النسيان (كما يقول) والكلام «خافت»، يمدح الكآبة والألم والذكرى والموت… ولعل الصوت الأليف الذي يسم غالبية القصائد لا يتأتى إلا من ذاك الإحساس الدرامي بالعالم والحياة والزمن: «نتذكر اليوم يقول الشاعر، إننا لم نصادف سوى الألم الذي حملناه في اليقظة، إننا لم نعد سوى نسيان ينسجه العابرون». ويمضي في ألفته الخافتة التي تخفي وراءها قدراً من السخرية السوداء والعبث واللاجدوى: «ثمة أسماء تأتي الآن في السر. كانت تغير الصدفة لنبكر في الشيخوخة»، ويقول الشاعر في قصيدة أخرى مستعيراً ضمير الجماعة: «متى سنصنع من رطوبتنا عمراً نتركه لأشباهنا الذين اختفوا؟».
يجد الشاعر نفسه مدفوعاً لاستحضار أشيائه الحميمية التي تحوطه ويحوطها من مثل الكتب والنظارات والمنافض والدواء والفنجان… لكنه لا يقع في أسر قصيدة الأشياء والتفاصيل (كما تجلت مثلاً لدى ريتسوس)، بل يظل حذراً حيالها، مكتفياً بالجو الذي تتيحه «الغرفة» شعرياً وهو جو شاحب وسوداوي. فالأشياء هنا لا تبرز لنفسها وإنما لأنها مساحة للتماهي والتمثل.
إلا أن إسكندر حبش الذي لم يتعبه “خفوت” كلامه لأن يلبث أن يستدرك ذاك الخفوت عبر الحب الذي يجعل المستحيل ممكناً، ولكن ليس في الكلام بل في عيشه. وإذا كان العاشق عادة يميل إلى الإعراب عن حبه فالشاعر يمعن في اختصار كلامه ليحيا التجربة ويجعل من المرأة شاهداً على العالم والنهايات والكآبة. غير أن الحب لا يبتعد هنا من بداهته ولا سيما حين يجعله الشاعر حيزاً للمقابلة بينه (كعاشق) وبين المرأة (كمعشوق). هكذا يتمثل الشاعر صورة العاشق الولهان المصاب بالوجد فيعترف ويبوح من دون أن يطيل ومن غير أن يتحايل على القول: “لم يبق لدي سوى جسدك”، يقول باختصار كلي. ويخيل إليه في حمأة ألمه واستعار كآبته، أن المرأة أضحت كالأيقونة فيجاهرها قائلاً: “يكفي أن ألمس جلدك”. ويخاطبها أيضاً: “ثمة مكان يسميني: أنت” ويعلن كذلك بلا تردد: “جسدك شغفي الوحيد”. أو: “ظلك كي ألغي ظلي”. وفي ختام مأساته يدرك العاشق في سريرته، أن العالم لا يحوي المعشوقة، فيغدو العشق ضرباً من ضروب المستحيل. ولا غرابة أن تبدو المعشوقة هي “نصف التفاحة” التي تحتل عنوان الكتاب، وأن التفاحة قسمها العاشق والمعشوقة على طول ارتعاشاتهما.
كان إسكندر حبش يوصف في منتصف تجربته بالشاعر “المقل”، لكنه خلال الأعوام الأخيرة غدا مغزاراً، لا سيما في الترجمة عن اللغة الفرنسية. وهو لم يهب الترجمة عن اللغة الوسيطة فنقل كتباً كثيرة، عالمية، عبر الفرنسية، وفي حقول شتى، الشعر والرواية والقصة والفلسفة…
من اليوميات
هنا مقاطع من اليوميات التي كتبها حبش خلال مواجهته المرض تحت عنوان «يوميات السيد سين»:
“أحاول في نهاراتي الرتيبة والمتشابهة أن أهرب من سطوة هذا الأمر. من سطوة السيد س. حلمت البارحة بالبحر. بالسير على الرصيف المحاذي وأنا أنظر إلى الأمواج التي تتكسر تحت قدمي. فكرت عندها: لو أستطيع أن أكون واحداً من تلك الطيور المحلقة. أن أكون فحسب، رفرفة جناح، لأقفز، ومن ثم أرحل بعيداً… سيكفيني بعض الفتات لأنقره كي أعيش. أما باقي الوقت فأحوم فيه فوق العالم.
هذا الصباح، وأنا في الطابق التاسع، وقبل البدء بجلسة العلاج، نظرت من شباك الغرفة. كان البحر أمامي بكل بهائه. لست في حاجة سوى لخطوات صغيرة كي أصل إليه. هذا ما تراءى لي. في المشهد أيضاً، حوض من أحواض مرفأ بيروت. سفن محملة تفرغ حمولتها. وفي السماء، تلك الطيور التي حلمت أن أكونها».
“ما أشعر به هو حال الحرب الدائمة التي أعيشها. حرب ضد من؟ ضد السيد س؟ من هو فعلاً هذا السيد س الخاص بي؟ إنه أنا. الأورام مصنوعة مني. تماماً كما أن عقلي وقلبي مصنوعان مني. إنها حرب أهلية تم اختيار الفائز بها بالفعل».
“لقد بدأ التعب يتسلل إلى مساماتي/ نوبة تستمر يومين في أقل تقدير أتعلم فيها كل لغات الصبر/ وأتعرف إلى جسدي من الأول بسبب الجرعات الكيماوية/ يحتل مستر سين كل شيء في الكتابة/ ولا يفعل سوى ترسيخ حضوره/ وأسأل نفسي هل يومياتي هذه سيرة».
عن الاندبندنت عربية