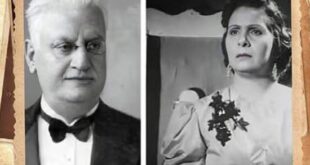شهلا العجيلي
رحل الروائي المصري رؤوف مسعد، في مدينة أمستردام، عن 88 سنة، بعد مسيرة أدبية وفكرية امتدت نحو 60 عاماً، جمع فيها بين الإبداع الروائي والكتابة الفكرية. وعاش متنقلاً بين القاهرة وبغداد وبيروت ووارسو وأمستردام، وترك إرثاً أدبياً غنياً ومتنوعاً.
واجه الروائي رؤوف مسعد، صاحب “بيضة النعامة” (1994) و”مزاج التماسيح” (1998)، و”إيثاكا” (2006)، بشجاعة فريدة الأنساق الثقافية المسيطرة في مرحلته، وكان أول المارقين من الروائيين في مرحلة تشظي الهوية القومية في العقود الأخيرة. وكانت له تصريحاته الإشكالية دائماً، التي تمثلها في نصوصه الروائية، إذ كان يجد دائماً أنه خارج عن كل سلطة نسقية: خروج عن النسق العربي المسيطر، ثم خروج عن النسق القبطي المسيطر بوصفه بروتستانتياً وابناً لكاهن عاش بين السودان ومصر، وخروج عن المنظومة القيمية التي يفرضها كل من هذين النسقين: “في رأيي أن الكاتب ليست وظيفته تأكيد الأخلاق السائدة في المجتمع، بمعنى أنه ليس رقيباً على المجتمع ولا على الأخلاق، حينما يكتب عملاً يجب ألا يكون له علاقة بالأخلاق، ليس ضد الأخلاق، ولكن في الوقت نفسه ليس خاضعاً لسلطة الأخلاق التي هي مفهوم متغير من مكان لمكان ومن زمان لزمان».
يمكن القول إن الدهشة التي كانت تتركها رواياته لدى قراء التسعينيات تحديداً، هي دهشة المروق، والسرد البسيط الذي يصل إلى الجوهر، ومواجهة الجسد، بخضوعه وتحوله إلى أداة للإخضاع، أو أداة مؤسسة حسب فوكو، ودهشة ذوبان أقنعة الهوية، والسلطة السياسية الدينية، والحكاية الذاتية بما تحويه من انتهاكات وخوف وأسرار.
كتابة التاريخ برؤية ذاتية
استخدم رؤوف مسعد في نصوصه الوسيلة الجمالية، للتعبير عن الخروج المستمر عن الأنساق جميعاً، ولم يتحرج من المساس بالآخر، وبحضوره الثقافي تصريحاً أو تلميحاً، غير عابئ بالردود ضده، فقد كان كما أشار مراراً يعاني أزمة فكرية، أساسها الشعور بالاضطهاد على المستويات جميعاً، ولعلها أزمة الاغتراب. أما تجلياتها فهي الالرواية التي احدثت سجالانزوع إلى التشكيك بكل شيء: بمعنى الوجود، وبالقيم كلها، بقيم الحياة، والإنسان، والعقل، والأخلاق، والحضارة.
حاول رؤوف مسعد في نصوصه إعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر الروائي/ الراوي، وهذا ليس جديداً إذا ما استعدنا قول “غوته” بأن التاريخ البشري يحتاج إلى من يعيد كتابته من وقت لآخر. ولعل تحويل التاريخ إلى نص قابل للتجدد يعني البحث عن ماضٍ قابل للاستخدام في الحاضر، وهذا يخدم خطاب النص، فالحكاية تاريخية، لكن الخطاب مرحلي، يقدمه الروائي ليوصل رسالة ما، مما يحول الأدب إلى عامل من عوامل التناحرات النسقية، فيصير الجمالي في خدمة الأنثروبولوجي، أو في خدمة الأيديولوجي.
ولعل هذا الخطاب العنيف في نصوص رؤوف مسعد هو واحد من “الطاقات التي تستجيب لمثيراتها وموضوعاتها العنيفة استجابة عنيفة، وغير موضوعية أو متجاوزة، إذ ثمة ظاهرة تكاد تتكشف فيها هذه النزعات كلها مجتمعة، وهي ظاهرة الموقف السلبي الثابت الصلب حيال كل شأن يتصل بالعرب، من حيث كونهم شعباً أو أمة أو مجتمعاً. إن كل ما في الحياة العربية: تاريخها، وثقافتها، وأخلاقها، وخصائصها، وظروفها الاجتماعية والسياسية والعقلية، وعلاقاتها الإنسانية الداخلية والخارجية، في قديمها وحديثها حتى اليوم، كل ذلك لا يستحق من الروائي/ الراوي هنا نظرة واحدة إيجابية. كل ما في حياة العرب من نقائص ونقائض صار عنده المقياس الأوحد المطلق للحكم في كل قضية تتصل من بعيد أو قريب بأية ناحية من نواحي الحياة العربية والإسلامية”، كما يشير حسين مروة في كتابه “دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي».
مواجهة العنف السياسي – الثقافي
كانت خطابات رؤوف مسعد واضحة وحادة بالنسبة إلى مرحلتها، إذ يواجه الراوي/ الروائي في “بيضة النعامة” مثلاً سطوة النسق العربي الإسلامي، مساوياً إياه بالاستعمارات العالمية الأخرى، بالعديد من النقود المنطلقة من موقف الهامش تجاه المتن: “إنها محاولة مسلحة للمقاومة، وعدم فرض دين وهوية الآخر عليهم، إنهم القبائل التي ما زالت تحاول بالقوة المسلحة الحفاظ على حقها الموروث والمنطقي في اختيار نظام حياتها الاجتماعي والسياسي والديني، بعدما كان النخاسون العرب والأوروبيون يخطفونهم، ليستعبدوهم في قصور الخلفاء من دمشق إلى بغداد إلى الباب العالي، ويصدرونهم إلى مزارع القطن في الأرض الجديدة في أميركا الشمالية والمستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا والمستعمرات الهولندية والإسبانية في الكاريبي. ومهما حاول العرب والأوروبيون والأميركيون التملص من هذه القباحة فلن يكون بإمكانهم دحض الحقائق والوثائق والأقبية… إنهم الآن لا يختفون في الغابات الاستوائية من نخاسيهم الجدد الذين يتمسحون بوحدة الإقليم ووحدة التراب لكي يحكموهم من جديد بقوانين واجتهادات مبتسرة …».
ليس الخروج عن النسق سوى مغامرة من المبدع، لكنها كانت في تلك المرحلة محسوبة النتائج من قبل النسق، بل يمكن القول في النهاية إن هذه الكتابة التي تستخدم أدوات متطرفة، أو محظورة في المقاومة، هي كتابة استباحية مباحة في آنٍ معاً، فالمؤسسة الثقافية تروض رعاياها بفرض القيود عليهم، وتقرر لهم سلفاً وسائل المقاومة، أي تحدد الفعل ورد الفعل أيضاً. وتتناول الكتابة في نصوصه بعامة مهمة تعرية كل من الكنيسة، والدولة، والجماعات الإسلامية، بحيث يفصح النص عبر القصة والسرد مشهداً وحواراً، بأن كلاً من قمع الدولة، وتخاذل الكنيسة فجرا التطرف الإسلامي، وأسهم هذا التطرف في المزيد من قمع المسيحيين، والمزيد من تشدد الدولة. في وقت يعلن فيه الراوي الخروج عن الأنساق كلها، التي يقمع بعضها بعضاً، يعلن تواطؤاً واضحاً مع نسقه الخاص جداً، وهو الأقلية البروتستانتية، التي يجدها الطرف الأشد ضعفاً في هذه العلاقة، لكونها معارضة في نشأتها وفلسفتها، على رغم توجيهه بعض النقد إليها عبر شخصية أبيه القسيس، التي يميل دائماً إلى تصويرها ضحية، كما يصور المسيحيين جميعاً على تلك الصورة مع توجيه بعض النقد إليهم أيضاً.
ليس هذا النقد سوى حيل سردية لمنح المتلقي إحساساً بموضوعية الراوي، الذي يتعاطف مع الأقليات المثلية، والمهمشة ذات الأنساق الخاصة، مقراً هنا بأعرافها النسقية، كما ذكر في أحد لقاءاته مع أحمد ناجي: “إني كاتب ممسوس بالجنس، لكني أيضاً ممسوس بهواجس أخرى، ممسوس بالحياة والموت والظلم والأقليات والمهمشين».
يتسع النسق لتلك الكتابة المعارضة، وكثيراً ما توظف الأنساق مثل تلك الكتابات المتطرفة لصالحها، بدليل أن المبدع لم يتعرض لمحاولة اغتيال أو اعتقال، بناءً على روايته هذه “اعتقل في 1960 لأسباب سياسية”، فـ”إن أي ثورة ضد السلطة لم تكن سوى وسيلة من وسائل السلطة لترسيخ وجودها، وبها تتوسع السلطة وتقوى”، كما يشير الغذامي، وذلك لأن الروائي استعمل أدوات الهيمنة ذاتها، التي تجلت بالنيل من النسق المسيطر الذي يخلق بممارساته عناصر وحركات تهدد أمن أفراده، كما يحاول النسق المسيطر النيل من المارقين عنه، لأنهم هم الذين يهددون أمن الأفراد بالتحريض، وإيقاظ الفتنة النسقية. فإذا ما كان هذا الخطاب يتخذ مشروعيته لكونه معارضاً للنسق المسيطر، من دون المساس بأفراده في أحسن حالاته موضوعية، فإن خطاب النسق المسيطر يتخذ مشروعية أوسع لكونه في هذه الحالة خطاباً لنسق منتهك، يدافع عن أمنه، لا سيما أن الانتهاك هنا يطاول أفراد النسق جميعاً بوصف النسق المسيطر ممثلاً شرعياً لهم، مما يحول الانتهاك هنا إساءة جمعية.
النزعة التدميرية تجاه الأنساق
يمكن للمتلقي أن يلاحظ أن السمة الأبرز لهذا الخطاب هي امتلاكه نزعة تدميرية تجاه الذات بانتماءاتها كلها، وتجاه الآخر المحايث لها في البنية الثقافية – الاجتماعية، عبر الرغبة في تدمير الأنساق التي تتحكم بكل من هذه الذات، وبالآخر فتجعله يقصي تلك الذات. ونستطيع التمثيل لتجليات هذه النزعة التدميرية بالعملية الانتحارية العسكرية، التي يفجر فيها الانتحاري نفسه، وأعداءه، والمحيطين به من ملته. وهكذا هو النص يفضح الذات، ويعلن خروجها عن نسقها الخاص، في سبيل فضح النسق المسيطر، أما النسق المعارض الذي يتم تصويره ضحية دائمة، فهو يسيطر على عناصره أيضاً، ويجبر هذه العناصر على أن تكون في مواجهة دائمة مع النسق المسيطر بشكل يسوغه الدفاع عن الوجود من جهة، كما يتم التعريض لماماً ببعض ممارساته من جهة أخرى وما ذلك إلا لإثبات صدقية الراوي وموضوعيته، بحيث يحاول الراوي أن يظهر ذلك التعريض هجوماً على النسق المعارض، يوازي هجومه على النسق المسيطر: “أدار بابا وجهه إلى الحائط… ونسي أسماءنا… مثلما نسيه الرب في الأعالي، ونسيته الكنيسة التي خدمها أكثر من 30 سنة، وأعطته أربعة جنيهات وأربعين قرشاً وعليه أن يدبر حاله. ولم يزره أحد من القسس الذين كان يستضيفهم في السودان».
«الأدب القبطي” مقولة استبعادية يرفضها الجيل الجديد
بتلك الأدوات وقفت نصوص رؤوف مسعد بخطاباتها العنيفة في مواجهة الأنساق كلها، الكبرى منها والصغرى، بنزعة تدميرية غير آبهة بالتابو، لتحول الخوف، والكبت، واللغة إلى روايات، يطغى فيها السرد على الحكاية، تعلن استغلال السلطة التاريخي للشعور القومي للمواطن، أو عن تسييسها الدين الإسلامي، ولا يوفر في ذلك قضايا الدين ذاته، كما في الأمثلة الآتية: “الجميع يريد السيطرة والفلوس، مرة بألا يعلو صوت على صوت المعركة، ومرة بتطويل ذيل الجلابية، وتغطية وجه المرأة… وهذا هو جعفر النميري الذي سكب خزين الخمر السوداني في النهر مقدماً سكرة مجانية للتماسيح، وهو السكير الذي لا يفيق، وهذا ليس بسر. وقطع أيدي اللصوص الصغار وأرجلهم حتى أنهم بعد الثورة ضده وإطاحته أسسوا نقابة لهم من كثرة عددهم، بينما كانت أمواله هو وأعوانه وطبقته محفوظة وآمنة في البنوك المسيحية البروتستنتية السويسرية، التي لا تتعامل بنظام المرابحة الإسلامية، بل بالربا”، وفي مثال آخر: “في الخرطوم، أغلقت الحكومة النوادي، وضربوا مرة أحد القساوسة الكاثوليك حينما كان يحمل زجاجة النبيذ الذي سيخدمه في المناولة وطبقوا عليه الحد… وبعض المحافظين أصدروا القوانين بإغلاق محال الخمور في محافظاتهم تملقاً للجماعات الإسلامية، ومنع بعض المحافظين بيع الخمر في رمضان وبقية الأعياد الإسلامية لجميع أهل مصر…»
إذاً، تعارض نصوص مسعد، لا سيما “بيضة النعامة” تحكم الأنساق أياً كانت، ويتكون كل من هذا الوعي المعارض، وإمكان التعبير عنه لدى الروائي/ الراوي/ البطل، نتيجة لخصوصية موقعه الثقافي في البنية الاجتماعية، إذ تتجاذبه انتماءات أربعة صاغت هوية الشخصية الإشكالية في نصوصه، وهي: انتماء مصري بما يحمله من بعد ثقافي – تاريخي “فرعوني، عربي، قبطي، إسلامي”، وانتماء مسيحي قبطي، وانتماء بروتستانتي، وانتماء ماركسي، و”كلما تعددت الانتماءات أضفت على الهوية خصوصية”، كما يقول أمين معلوف، وجعلتها أكثر إشكالية، وزادت من احتمالات المواجهة، نتيجة لتعدد الآخر، وتشظيه إلى آخرين.
عن صحيفة الاندبندنت
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …