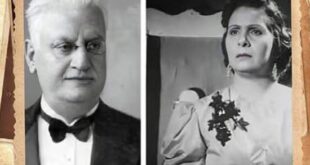ممدوح النابي
امتثل رؤوف مسعد عند كتابة سيرته إلى أدبيات السيرة الذاتية، فكانت أقرب إلى التعرية منها إلى تأمل مسيرة حياته، فالسيرة كما تعارف الدارسون هي ألا تكون صادقة إلا بقدر ما هي مشينة .
رحل الكاتب المتمرد رؤوف مُسعد المولود في بورتسودان 1937، عن عالمنا بعد رحيل رفيق دربه صُنع الله إبراهيم بأشهر قليلة، وكأنهما كانا على موعد للقاء من جديد بعدما فرقتهما الدروب والبلدان والمشاغل، رحل بعد رحلة عطاء باذخة في الكتابة الإشكالية والمتمردة على اختلاف أنواعها؛ الروائية والقصصية والمسرحية والسيرية، وكذلك الكتابة الفكرية، بدأ مشواره الكتابي بكتاب مشترك مع رفيقي دربه صُنع الله إبراهيم وكمال القلش بعنوان «إنسان السد» 1967، ثم توالت أعماله المنفردة التي كسرت الخط السائد والنمطي في الكتابة العربية، على المستوى الجمالي والأيديولوجي.
فاستطاع بهذه الكتابة المغايرة والحادّة أن يصنع لنفسه مكانًا فريدًا بين كتّاب جيله ممن عرفوا بجيل الستينيات (أو جيل بلا أساتذة)؛ جيل التمرد على النظام الأبوي بمفهومه الواسع، فقدّم للمكتبة العربية نصوصًا لافتة مثل “بيضة النعامة” (1994)، و”مزاج التماسيح” (2000)، و”في انتظار المخلّص رحلة إلى الأرض المحرّمة” (2000)، و”إيثاكا” (2007)، وصولًا إلى سيرته “لمّا البحر ينعس” (2019) وغيرها من أعمال إبداعية وفكرية، انطلق فيها من الذاتي إلى الموضوعي، وجعل تجربته الذاتية بكل ما تحمل من هواجس ومعاناة ومصادرة وتنظيمات سرية، وتمرد، وهروب من الواقع ومن البوليس، وسجون واعتقالات، وإخفاقات في الحب والزواج، وأسفار ورحلات متعدّدة، وصراعات أيديولوجية؛ انعكاسًا لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي متأزم، يرفع شعارات لا مكان لها على أرض الواقع، ومن ثمّ كشفت كتاباته عن همّه الأول بتطلعه وشغفه إلى/بـ الحرية ورديفاتها، فالتمرد لم يكن إلا بحثًا أو تقصٍ عن هذه الحرية بكافة صورها؛ دينيّة، وجنسية، وحرية في الكتابة دون التقيد بشكل أو نمط محدد سلفًا بأطر وقواعد نظرية، فالكتابة عنده نهر متدفق، بلا رتوش أو تشذيب، يكتب دون ترتيب أو تنظيم، أشبه بسيلان جارف أو على حد قوله: “أنا بحكي الحكاية زي ما بتيجي في دماغي”، وأهمها الحرية السياسية، التي إذا تحققت، تحققت معها الحريات الأخرى جميعها، وهو ما اضطره لأن يجعل جلّ اهتماماته القبض على جمرة الكتابة كي يصب فيها أفكاره “بشكل لا تظهر فيه عنصرية دينية أو تعصب عرقي ممقوت».
يعدُّ رؤوف مسعد بشخصيته البسيطة (على المستوى الإنساني؛ بوده وتفاعله مع الكتابات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بحميمية وصدق وبراءة، وعلى المستوى الكتابي؛ فلا يكتب كتابة منمقة مزخرفة، بل يكتب ما يعن له بما فيه خرق للأعراف دون حجب أو مواربة)، وبكتاباته التي جاءت خارج النسق الأدبي، كاتبًا استثنائيًّا بامتياز في كلِّ شيءٍ، بدءًا من انشغاله بالجسد وبإغوائه لأبعد حدٍّ، حتى إنه يراه «مركزَ العالم، ومحور حروبه، وملعب انتصاراته وهزائمه»، فَعدَّت كتاباته النموذج العربي للإيروتيكية، مرورًا بأنه الشخص الوحيد الذي عاش في الغرب ردحًا من الزمن دون أن تأخذه نداهة الكتابة بلغته، على نحو ما فعل كُتَّاب الفرانكفونية، وغيرهم كأمين معلوف اللبناني وأهداف سويف المصرية، بل ظَلَّ وفيًا لعربيته يكتب بها حتى آخر نفس في حياته، أو لاختراقه في كتاباته لكافة التابوهات الأخلاقية والدينيّة والسياسيّة، مرورًا بآرائه الصَّادمة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية؛ فالإباحية عنده «ليست فِعْلاً في الجسد، ولكنها فعلٌ في العقل أيضًا»، وأن نشاط نواب الإخوان في البرلمان «هو نشاط جنسي»(1) والرَّبيع العَربي «ليس ربيعًا، وليس خريفًا» لكنه «شتاء سخطنا»، والثقافة في رأيه «تحجَّرت بعد إغلاق باب الاجتهاد»، وأن شتاء السخط الذي نعيشه، نِتَاجٌ طبيعي لوجود ثقافة شائهة ومريضة تأسَّست على قرون من القهر والمداهنة والتماهي مع السَّجان(2)، مرورًا بزيارته لإسرائيل والقدس بناءً على اقتراح التليفزيون الهولندي وتبعاتهما عليه باتهامه بالتطبيع والعمالة، إلى جانب اتهامه بمدافعته عن المثلية، وصولًا إلى تأييده لـ»حماس» قلبًا وقالبًا، رغم تحفظه واختلافه أيديولوجيًا، إلا أنه ناصر موقفها في نضالها ضد عدو تخشى أنظمة بكافة عتادها وعدتها مواجهتها، بل تسعى إلى استقطابها بمصطلحات فضفاضة كالتطبيع، والاتفاق الإبراهيمي. ومن شدة تأييده لموقف «حماس» المقاوم انتقد المعارضين والمتهمين لها بالخيانة والتمويل الخارجي، قائلًا: «على مَن ينتقد «حماس» ويتهمها بالخيانة والتمويل الخارجي، أن يمسك هو السلاح، أو يمولها. عدا ذلك مزايدة فارغة لا قيمة لها».
هذا الاستثناء، جعله في فرادةٍ من بين كُتَّاب جيله، فشجاعته لم تقف عند حدود كتابة جريئة مخالفة للأعراف الكتابية أو حتى الأخلاقية، وإنما تعدت هذا وذاك إلى شجاعة في المواقف والآراء، وهو ما عرّضه للاعتقال والحبس في أشدها تنكيلًا، وفي أقلها ضررًا بالانتقاد واللوم لمثل هذه المواقف على نحو ما حدث له أثناء زيارته إلى القدس، فانتقده جميع الكتاب باستثناء عبلة الرويني وعبد المنعم رمضان، الوحيدين الذين دافعا عن موقفه، أو ما تجلّى بآرائه الحادة والشجاعة في كتابات بعض الكتاب (الغيطاني وزيدان)، واتهام البعض بالسرقة الأدبية، وكذلك رأيه في الجوائز الأدبيّة وآليات تحكيمها.
وقد كَشَفَ هذا الاستثناء وتلك الفرادة من جهة ثانية، عن صِفَةٍ أَصيلةٍ في تكوينه، ومُطَّرِدَة في إبداعه، وهي الصِّفة البادية في المشهد الاستهلالي لنص “إيثاكا” الصّادر عن دار ميريت 2007، حيث ينفتح النص عن “تلميذ صغير يخرج عن السطر دائمًا، ولا يمشي عليه رغم العقوبات المتتالية التي تنهال عليه من معلمته، قاسية القلب للخروج عن السطر”. المشهد بكل دلالاته الكاشفة عن عناد الطفل وإن صحَّ تمردُّه، وردّ فعل السلطة الباطشة (المعلمة هنا)، هو صورة مُعبرِّة ومُلخِّصَة لحالة ذات المؤلف المتماهية مع ذات الطفل، لنصبح بإزاء ذات ليست مخاتلة أو حتى أنها ذات متعدِّدة، تتواءم مع الأيديولوجيات السائدة، بل على النقيض تمامًا فهي ذات متمردَّة ثائرة ورافضة لكل ما يتعارض مع الحرية، ووأد الذَّات أيًّا كانت سلطتها، وهو ما جعله في صدام دائم، ليس مع السلطة السياسية وفقط، بل يتجاوزها إلى صدام مع السُّلطة الدينية (الكنيسة والتيارات الإسلامية) وسلطة الأعراف والمواضعات الاجتماعية. ومن ثمَّ جاءت كتاباته/حالاته مواجهة لها؛ متخذًا من الصَّراحة المُوْغلة والصدق العاري أداتين لهدم كافة التابوهات، وإزالة أوراق التوت التي ندَّعيها زورًا لمواراة كافة أكاذيبنا وتناقضاتنا وأيضًا قهرنا للآخرين، لهذا فكتاباته دائمًا تثير الجدل، لكونها صادمة، وعارية من كل زيف، بمعنى أدق لأنها حقيقية، تواجهنا بذواتنا، قبل ذات رؤوف مسعد.
لا ينفي مُسعد صفة التمرُّد عنه أو حتى ينكرها، بل يؤكِّدها في كتاباته وحواراته فيقول: “أنا متمرّدٌ بالسليقة على أسرتي، وطبقتي، وديانتي، وعلى مبدأ الكتابة التقليدي”(3) ومن ثمّ لا نتعجب من تمرده، وهو ابن قس على المؤسسة الدينيّة، التي نذرته الأم لها كخادم للرب، فما إن اكتشف الشيوعية حتى هرب من مؤسسة الكنيسة إلى مؤسسة الشيوعية. فاعتناقه الشيوعية كان تمردًا على الأسرة والكنيسة وعلى كل ما كان سابقًا من دين وعقيدة. فهو لا يؤمن بجنة أو جحيم ولا بالقيامة، فقط هو يؤمن من أنه حينما يتعرف على “إلاهته سوف نتحرك سويًّا حتى يوصلني إلى مرادي».
وهو ما قاده ذات مرَّة لأن يُعلن رغبته في الانضمام لـ»حزب الله» وهو المسيحي، كاتساق مع قناعته الرافضة لتقسيم الناس على أساس ديني، كما إن تمرده ليس متعلقًا بانغماسه في اليسار والتيارات المعارضة التي أدخلته السجن مبكرًا، بقدر ما هو بنية متغلغلة في ذاته تكشف عنها حالاته الكتابية، والمتتبع لسيرته الموزَّعة على نصوصه يرى ملامح هذا التمرُّد بادية في هجراته المتعددة بحثًا عن الهوية المسيحية المصرية «المهاجرة» التي أشبه بـ»سنوحي» كما وصفها، بدءًا من هجرته الكنيسة كمؤسسة دينية عندما هاله الظلم، واكتشافه عالم الفوارق الطبقيَّة وسط القساوسة، وهو ما دفعه إلى أن «يلتجئ إلى الماركسية باعتبارها ملاذَ المظلومين، والمبشرة بأرض الميعاد التي يتساوى فيها البشر»(4) وإن كان تقبَّل الكنسية كتيار ثقافي مُتحرك، إلى هجرته من السودان إلى مصر، وهجرته من مصر إلى الغرب وإلى العالم؛ باحثًا عن «الهُويَّة» وعلاقتها بالمكان (أي الوطن) ثم علاقتها بالدين (اليهودية والمواطنة) ثم علاقتها بالصراع العرقي الذي قد يكون واضحًا بلا أقنعة مثلما كان في جنوب أفريقيا قبل تحرُّرها من سيطرة «العرق الأبيض»، أو متخفيًا خلف أقنعة القومية وأقنعة الوطنية وأقنعة الدينية (كذا) كما جاء على لسانه في إحدى الحوارات.
وقد يأتي التمرُّد كنوعٍ من المغامرة أو الفرادة على نحو تمردُّه على الكتابة الروائية في أوَّل الأمر، واتّجاهه إلى المسرح ليكون مميَّزًا عن زملائه (صُنع الله إبراهيم، وكمال القلش، وعبد الحكيم قاسم)، ثم تمرّد على القوالب والأنماط الشَّكْلية المألوفة، فهو أولًا رافض للمسميَّات الشكلية، كنصٍّ روائي أو سيرة، فقد تأتي جميعها في حالة واحدة، ومتضمِّنة لأشكالٍ جديدة كالريبورتاج الصحفي (عن العشوائيات في إمبابة بعد سعي الجماعات لتأسيس الجمهورية الإسلامية فيها، عمَّا حَدَثَ وكيف حَدَثَ؟) كما في «بيضة النعامة» 1994، والتي رصد فيها حالات التغول لدى الجماعات الإسلامية، إلى درجة التفكير في الاستقلال وتكوين جمهورية مستقلة كما حدث مع الشيخ جابر، الذي أعلن استقلال إمبابة، وأنها جمهورية إسلامية. لكن الجميل في الرواية أنها أدانت تراخي الدولة وأجهزتها في عملها، حيث كان لهذا الإهمال الأثر المهم في انتشار العشوائيات التي كانت حاضنة للفكر المتطرف ونقيضه تجار السلاح والمخدرات. فالمدينة ظهرت في أواخر الستينيات حيث كانت تستخدم كمكان لإلقاء زبالة المدينة، فيرصد الرواي تنامي الفقر في هذه المنطقة، وتركيبة سكانها التي يغلب عليهم انحدارهم من الجنوب/الصعيد حيث الفقر، والهروب من الثأر الدموي الذي يُلاحق البعض، كما احتلّ هذه المنطقة تجار السلاح والمخدرات ومَن يبحثون عن أماكن آمنة للفرجة على أفلام البورنو. وكيف بدأ صغار المشايخ احتلال الجوامع والزوايا والتحريض ضد المخالفين، ومن ثمّ انتشرت المعارك بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتحولت شوارع المدينة إلى ساحات حرب بعد اقتحام الحكومة وكر الإرهابيين. هكذا، «ذات ليلة حشدت الحكومة حسب التقارير الرسمية عشرين ألف جندي ودعمتهم بالأسلحة الرشاشة والسيارات المصفحة، أعلنت الحكومة الحرب على الشيخ جابر، فقدت الدولة ماء وجهها بعد أن نقلت الأقمار الصناعية صور الشيخ جابر وتصريحاته النارية التي أعلن فيها قيام جمهوريته الإسلامية التي ستزحف جحافلها – كما قال – على بقية المناطق الكافرة لترجعها بحد السيف مرة أخرى إلى الدين الصحيح».
أو تأتي الرواية حاوية للتقارير والتحقيقات، والشهادات إضافة إلى المدونات الخاصة كما نجد في نص “إيثاكا” الذي يعج بالاعترافات الخاصة التي أدلى بها بعض الضحايا الذين تمكنوا من الوصول إلى هولندا، وكشفوا عن الأساليب الوحشية المروّعة التي استعملتها أجهزة الأمن والشرطة المصرية، وكذلك فريق الأطباء الموكل لهم فحص المتهمين، أثناء التحقيق معهم بتهمة “المثلية”، وازدراء الأديان، وبذلك تبدو كتاباته أو حالاته مزيجًا من السيرة ومزيجًا من تفاصيل الحياة اليومية، وتأثيرات السياسة على الواقع، ومزيج من الخطابات المضادة، وهو ما انعكس على شخصياته التي هي الأخرى مزيجٌ من الشّخصيات الحقيقية؛ كشخصيته (هو) ووالده، وخاله، وأصدقائه، وأخرى لها حضورها العام، كسعاد حسني وناتاشا الروسية، أو ما يَطْلق عليهم الشهداء باختلافات انتماءاتهم الأيديولوجية (مثل: سليمان الحلبي، وعمر مكرم، وشهدي عطية، والشيخ ياسين، ومحمود محمد طه، وعبد الخالق محجوب، وفرج الله الحلو، وفهد العراقي، وإميل حبيبي، وشبل الطنطاوي، وسيد قطب، وسمير قصير، وجورج حاوي) باعتبارهم ضحايا العنف، والشخصيات المتخيَّلة كشخصية المُرَمِّم على سبيل المثال في “إيثاكا”، أو حتى شخصية سعاد حسني، فرغم واقعيتها، لكن استدعائها والحوار معها أضفى بُعْدًا خياليًا عليها، وإنْ غلبت الشخصيات ذات المرجعية الواقعية على نصوصه، وثانيًا في رفضه القطعي لمواصفات الكتابة الروائية التقليدية، منذ أنْ دَشَّنَ مانفستو الكتابة الجديدة مع كمال القلش وصُنع الله إبراهيم، في مقدمة رواية “تلك الرائحة”، ومن ثمّ غابتْ في مجمل نصوصه (باستثناء صانعة المطر) الحكاية الكلاسيكية القائمة على مراعاة التسلسل والترابط بين عناصرها، وإنما هي عبارة عن نثار حكايات قد تبدو متباينة في موضوعاتها. على نحو ما هو واضح في “بيضة النعامة” دار مدبولي 1993، ففيها ثمَّة حكايات متناثرة أو بمعنى أدق سيرة ذاتية أو روائية شذرية، محدودة في الزمان والمكان، عن ذات المؤلف وعن رحلاته المتعدِّدة وعن سجنه، وعن علاقاته بأصدقائه، وفي أحد جوانبها سيرة للكتابة حيث يكتب عن أعماله مثل مسرحية “مقتل لوممبا” ومسرحية “يا ليل يا عين” التي كَتَبَها عقب الخروج من السّجن، وكذلك كتابه المشترك مع صديقيه عن “إنسان السَّد العالي».
ومثلما يبدو ـ في النَّص متمردًا على أشكال التنميط والقولبة، نجده أيضًا مُخْتَرِقًا للمحظورات ومحطِّمًا للتابوهات في المجتمع، فيكسرُ تابو الأقباط ويكتب لا عن حياتهم ومعيشتهم، وعلاقاتهم المتشابكة مع جيرانهم المسلمين، كما في نماذج إدوار الخراط ونعيم صبري، وإنما يكتب عن معاناتهم نتيجة للطائفية، وما تعرَّضوا له مِنْ حَرْقٍ لكنائسهم ومحلاتهم التجارية كما حدث في أسيوط، وفيه أيضًا يُعرِّج للانتهاكات الجنسيّة التي يتعرَّضُ لها المساجين. ومن ثمَّ نجدُ أنفسنا في سباقٍ محمومٍ مع المكان والزمان وتداخلاتهما، لكن في النهاية عبر تراكم مجموع الأحداث نقفُ مع نصٍّ يشاكسُ واقعه المُنْتَج فيه، وكأنه يعارضه على مستوى البناء، فإذا كان الواقع آخذًا (هو الآخر) في التحلُّل والتفكُّك في بنيته؛ فثمَّة طائفية، وثمة أصولية إسلامية بدأت تؤسِّس لجمهوريتها كما حدث في إمبابة، وثمَّة تحولات وإحلالات على مستوى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بسبب تغيير منظومة المجتمع بعد الانفتاح السَّاداتي وعودة العَمَالة بالمال من الخليج وتأثيرهما في تغيير نمط القيم، وانتشار موجة التأسُّلم. وأيضًا ثمة حضور باذخ للجسد، يتبعه وصف للعلاقات الجنسيّة بكافة أشكالها سوية ومثلية، وكأن النّص يريد أن يضعَ الجسدَ المقهور في مواجهةِ جَلَّاده ليكتشفَ “ذاته”، فصارت النساء ـ أجسادهن ـ بالنسبة له “بوابة الأمان وتحقيق الذات”(6)، فالذات كما يرى فوكو “ليست في حقيقة الأمر سوى جسد متناهٍ يقيم علاقته بالوجود، بحيث تشتبك مع الواقع اشتباكًا ناشطًا يُمْسك بالذات في أوج حيويتها وانفعالها بالعالم” .
عن موقع ميغازين
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …