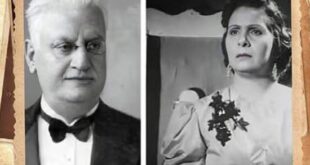نادر كاظم
حَرص فانون أن يكتب سارتر مقدمة «معذبو الأرض» لأنه اعتقد أن شهرة الفيلسوف الفرنسي الكبيرة ستساعد كتابه على الانتشار. رحّب سارتر بفكرة كتابة المقدمة، بل إنه أُعجب بالكتاب وبشخصية فانون حتى أن كلود لونزمان، محرّر مجلة «الأزمنة الحديثة» والصديق المشترك الذي رتّب اللقاء في روما، علّق بأنه «لم ير سارتر مفتوناً بأحد فتنته بفانون في هذا اللقاء». بقي الاثنان، وبحضور لونزمان والفيلسوفة الفرنسية مؤلفة كتاب «الجنس الآخر» سيمون دي بوفوار، يتحدّثان بلا انقطاع طوال اثنتي عشرة ساعة بدأت منذ وجبة الغداء إلى وجبة العشاء وطوال المساء حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. لم يقطع هذا الحديث المتدفّق سوى تدخّل سيمون دي بوفوار الصارم وإصرارها أن سارتر بحاجة إلى النوم، فما كان من فانون إلا أن عبّر عن استيائه من هذا التصرّف قائلاً للونزمان: «أنا أكره الذين يدّخرون مواردهم»، وأضاف بأسلوب لطيف أنه مستعد أن «يدفع عشرين ألف فرنك يومياً لمواصلة الحديث مع سارتر». روى هذه القصة إدوارد سعيد أيضاً في فصلٍ في كتبه بعنوان «عندما التقيت سارتر» ووردت الرواية في كتاب فخري صالح بعنوان «إدوارد سعيد: دراسة وترجمات» الصادر سنة 2001.
لم ينم فانون يومها. فقد وصل لونزمان ودي بوفوار إلى المطار لاستقباله في قاعة الانتظار، وبقي فانون «في السيارة المتوجّهة إلى فندق [الذي يقيم فيه] سارتر، يتحدّث بشكلٍ محموم عن المجهود الحربي…» في حرب التحرير الجزائرية التي كان يعرف كل تفاصيلها. واتصل حديث السيارة بالحديث الطويل مع سارتر، ثم تواصل مع لونزمان حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. كان فرانز فانون مفعماً بالحيوية قادراً، قبل أن يمرض، على العمل من سبع عشرة إلى عشرين ساعة في اليوم. لكن مرضه العصيّ على العلاج جعله لا يهدر ساعة واحدة في النوم، بل إنه كان يكره من يدّخر صحته وكأنها موردٌ يتناقص بالإنفاق.
وصفتْ سيمون دي بوفوار فانون في هذا اللقاء أنه «حادّ الذكاء ومفعم بالحيوية ويتمتع بروح الدعابة الكئيبة وحاد الطرح في الأسئلة وبارع في المحاكاة الساخرة وقادر على وصف الأحداث كما لو كانت تقع أمام أعين المستمعين». إلا أن فانون في اللقاء الثاني مع سارتر كان مجرّداً من كل هذه الصفات، ولو قُدّر لأحد أن يرى فانون في اللقاء الثاني فلن يصدّق أنه نفس الشخص الذي كان موجوداً في اللقاء الأول. وصل فانون إلى روما في سبتمبر 1961 في طريقه إلى واشنطن للعلاج من سرطان الدم الذي جعله خائر القوى. وعلى خلاف اللقاء الأول، اضطر جان بول سارتر هذه المرة إلى الذهاب بنفسه إلى الفندق الذي يقيم فيه فانون الذي بدا منهكاً من الرحلة مستلقياً على سريره عاجزاً عن الحركة. حاول سارتر الحديث معه لكنه كان عاجزاً حتى عن الإجابة، ومع هذا كان وجهه متوتراً وظلّ يتحرّك على سريره وكأنه يُظهر الاشمئزاز من حالته الجسديّة. غادر سارتر اللقاء وهو في غاية الحزن، فشتان بين فانون في اللقاء الأول وفانون في اللقاء الثاني، بين فانون المفعم بالحيوية الذي لا يكفّ عن الحديث على مدى يوم كامل وفانون الآخر خائر القوى طريح الفراش، العاجز حتى عن الإجابة عن السؤال. لكن هذا ما كان يقصده فانون حين أبدى استياءه ممن يدّخر صحّته كبخيلٍ يدّخر ماله لغده، ثم يموت قبل أن يأتي هذا الغد المنتظر.
كان فانون في اللقاءِ الثاني نسخةً حزينةً وذابلةً من نفسه في اللقاء الأول. وبقدر ما كان المرض ينتشر ويستفحل في جسد فانون، كان هذا الجسد يَضمُر وينكمش حتى فقد المفكّر الفرنسي الكثير من وزنه وبدا كطفلٍ في العاشرة من عمره. كان كتابُ «معذبو الأرض» سيّدَ اللقاء الأول والثاني بين سارتر وفانون، وهو كذلك الحدّ الفاصل بين فرانز فانون قبل المرض وفرانز فانون بعد المرض. بدأ كتابته إبان مرضه وانتهى منه وقد هدّ المرض جسده. نُشر الكتاب وفانون على فراش الموت وقد قرأ كتابَه أو قُرئ عليه، ثم مات.
الإنسان عرضة لصروف الحياة وحوادثها التي تؤثّر فيه وتغيّره تغييراً كبيراً مثل المرض الخطير والشيخوخة. العنصرية تفعل ذلك أيضاً، والعنصرية موضوع كتاب فرانز فانون الأول «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء». تفرض العنصرية على الأسود أن يكون أكثر بياضاً أو أن يبقى حبيس سواده كارهاً الأبيض، وتفرض على الأبيض أن يكون منغلقاً على نفسه معتقداً تفوّقه. العنصرية بهذه الطريقة إنما تغيّر الأسود والأبيض معاً وتفعل بالاثنين ما يفعله المرض بضحاياه، فتحوّلهم إلى أشخاص مختلفين ومرضى نفسيين يحتاجون، برأي فانون، إلى العلاج لإخراجهم من هذه الحالة. يكتب فانون أن «الأسود عبدٌ لدونيّته، والأبيض عبدٌ لتفوّقه»، ويتصرّف الاثنان بطريقة مرَضَية عُصابية. فالأبيض الذي يمقت الأسود ويحتقره مريضٌ عصابيّ مثل الأسود الذي يكره الأبيض، أو يسعى لأن يظهر أمامه وكأنه أكثر بياضاً مما هو عليه في الواقع.
يؤمن فانون بكونيةٍ إنسانيّةٍ استمدّها من عصر التنوير الفرنسي في القرن الثامن عشر، وظلّ يبشّر بها منذ أول كتاب له سنة 1952 بعنوان «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء» حتى آخر كتبه في سنة 1961 الذي حمل عنوان «معذبو الأرض». كان فانون يرى أن المسألة تتصل بالإنسان وليس بلون بشرته، فالعنصريّ يحتقر الإنسان حين ينفي الصفة الإنسانية عن الأسود، وحين يتوهّم أن الأبيض هو وحده الإنسان الحقيقيّ دون سواه من البشر. طالب فانون بالثورة والتحرير سنة 1952 حتى قبل انضمامه للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1956. الثورة التي طالب بها فانون سنة 1952 كانت ثورة إنسانيّة ضد النظام العنصري، ثورةٌ تمهّد الطريق «نحو إنسانيّة جديدة» وثورة تحرّر الإنسان من أمراضه وأغلاله ليعيش في عالم يؤمن بالإنسان بمعزلٍ عن لونه وعرقه.
أراد فانون أن يكون كتابه «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء» بمثابة «دراسة عيادية سريرية» لمرضى العنصرية من البيض والسود معاً، فخصص كتابه للتركيز على العديد من الحالات التي عايشها أو صادفها مرّاتٍ عدة لمرضى كثيرين قصدوه طلباً للعلاج. من أمثال ذلك، الأسود الذي يريد أن يكون أكثر بياضاً بقدر اتقانه اللغة الفرنسية واحتقاره لغةَ أسلافه، والمرأةُ السوداء التي تريد أن تكون بيضاء أو أن تحظى ببعض البياض لمجرد أن يحبّها رجل أبيض، والرجل الأسود الذي يريد أن يصير أبيض لمجرد أن تحبّه امرأة بيضاء، والأسود المارتينيكي الذي لا يرى نفسه «زنجيّاً» لأن «الزنوج» يعيشون في إفريقيا فقط، والأسود المارتينيكي نفسه الذي يكتشف أنه «زنجيّ» مثل الإفريقيّ بمجرد أن تطأ قدمه أرضاً أوروبية، والرجل الأسود الذي يضاجع البيضاء انتقاماً، والطبيب الأسود الذي أراد أن يكون طبيباً في الجيش الفرنسي لا لشيء سوى أن يكون تحت إمرته مرضى بيض، والأسود الذي يبحث عن هوية سوداء خالصة ونقية ردَّ فعل على الأبيض الذي يعد السواد انحرافاً لا إنسانيّاً. تعامل فرانز فانون، الطبيب النفسيّ حديث العهد بالمهنة، مع هذه الحالات على أنها حالات مرضية وعقدُ نقصٍ أو تفوّقٍ تتطلب تدخّلاً علاجياً، واعتقد أن المرضى الذين سيتعرّفون على حقيقة مرضهم في هذا الكتاب «سيخطون خطوة إلى الأمام» على طريق العلاج.
أبدى فانون في الكتاب وعياً مبكراً بقوة تأثير الاستعمار في بنية العنصرية في المركز الاستعماريّ وفي المستعمرات، وذكر في الكتاب أنه لن يشفق مطلقاً «على الحكّام المستعمِرين القدامى» بل سيجعلهم هدفَ نقده مثل سود المستعمرات المرضى. أراد عندما ناقش مسألة «الأسود واللغة» في الفصل الأول بكتابه توسيع دائرة استهدافه من السود إلى كل إنسان مستعمَر، إلى «كل شعب مستعمَر – أي كل شعب نشأت في صميمه عقدة الدونيّة، بسبب دفن الأصالة الثقافيّة المحليّة – يتموضع بإزاء لغة الأمّة المتحضّرة، أي الثقافة (ثقافة بلد المستعمِر)». إلا أن فانون عاد ليقرّر أن الاستعمار ذو طبيعة عنصرية، إلا أنها ليست عنصرية استثنائية ومتفرّدة بين مختلف أنواع العنصرية، وهو لا يرى فرقاً كبيراً بين معاداة السامية ومعاداة اليهود، وبين العنصرية الاستعمارية تجاه الشعوب المستعمَرة. فكلتاهما عنصريّتان تُجرّدان الإنسان من إنسانيته، وتتعاملان معه بدونية واحتقار، سواء كان أسودَ مستعمَراً أو أبيضَ يهوديّاً.
· مقتطف من دراسة نشرت في مجلة الفراتس
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …