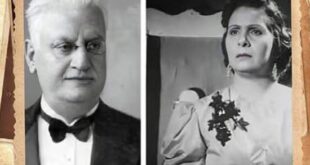يحيى جبر
من أعيان التراجمة في هذا العصر عادل زعيتر، وهو يحتل مكانا رفيعا بين المترجمين، ويمتاز أداؤه عن غيره بعدد كبير من الصفات الحميدة، ونستعرض في ما يأتي جملة ما أسهم في تكوين كفاءته ومكنته، وما ارتقى به وبعمله هذه المكانة العالية.
أولا: علو همته وإصراره وذكاؤه.
فقد عرف عنه أنه كان يأخذ نفسه بالعزيمة منذ صغره، وكان متفوقا في دروسه “فلقد كان دوما من الأوائل في دراسته وفي إتقانه لما يتعلم من علوم أو لغات، أو ما يقوم به من عمل وجهد” (الكيلاني ص 3) “وفي عام 1946 وقد اشرف على الخمسين من عمره، أحس بانقضاء أكثر العمر، ومن يدري ما تبقى منه؟ فقرر اعتزال المحاماة والاعتكاف كليا في صومعته مكرسا وقته وجهده وحياته وماله للترجمة، وحين أقول وقته وجهده فلقد كان ذا طاقة جبارة يعمل في مكتبه بين القراءة والكتابة والتنقيب عن الكلمات والمعاني بمعدل اثنتي عشرة ساعة يوميا يكاد خلالها لا يأكل ولا يشرب ولا يقابل أحدا” (الكيلاني 3) وفي هذا ما يشير إلى انه كان طوال عمره على وتيرة واحدة من الجدية والاجتهاد. ويعبر صديقه محمد علي الطاهر عن هذه الروح التي امتاز بها عادل فيقول: “إن عادل حين تبتل للعلم كان قد عزف عن مباهج الدنيا وعن السياسة منذ رأى الدجاجلة يظهرون، وأهل الغوغائية يبرزون، وأهل الحِمى يهملون، فتقززت نفسه من سوء ما رأى، ونأى بخلقه القويم عما يتهافت عليه أبناء جيله… لذلك انصرف عادل عن المحاماة وكان من أعلامها، ونذر نفسه للقيام بمهمة تنوير العقول والارتفاع بالأفهام، فكان عادل بهذه المثابة سراجا لأمته ومنارا لقومه، وسوف يعجز كل من يأتي بعده، وسيحير الذين يتصدون بعده للترجمة ونقل علوم الغير من لغة إلى لغة، وما مات عادل ولحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن قام بما تعجز المجامع العلمية عن القيام به، وناب عن الجامعات في تقريب العلم إلى الناس، بل قام وحده بما لم تستطع الحكومات أن تقوم به” الطاهر 345، 346.
وفي هذا المعنى يقول محمود الأرناؤوط (23، 24) “واستطاع أن يتحول بدأبه وجهده وصبره وكفاحه إلى علم من أعلام الأمة الخالدين وان ما استطاع أن يقدمه إلى قراء العربية من نفائس الأعمال العلمية الرصينة لجمهرة من عمالقة الثقافة في فرنسا في العصر الحديث، بلغة راقية، وأسلوب عالي المستوى، ليشهد له بالعبقرية والنبوغ.
فهذه شهادات توضح ما كان عليه زعيتر من الإصرار والعزيمة وبعد الهمة، مما أتاح له ما لم يتح لغيره فكان في عصاميته واعتداده نسيج وحده.
ثانيا: تبحره في الثقافة الأجنبية
امتاز عادل زعيتر بسعة اطلاعه وإقباله على المعرفة بنهم شديد، فبعد احتلال الفرنسيين لدمشق غادرها إلى باريس ليدرس القانون، “وهناك تشرب الثقافة الفرنسية، وقرأ أعمال المفكرين السياسيين الفرنسيين قراءة مستفيضة” أبو غزالة 43 وقد مكنه من ذلك إتقانه للفرنسية والإنجليزية والتركية، مما أتاح له فرصة الاطلاع على آداب الشعوب الناطقة بها الإحاطة بعلومها وإنجازاتها.
“إن الثقافة العالية الرفيعة التي وصل إليها عادل زعيتر بجده وسهره ونشأته في المحيط الوطني المجاهد الذي عاش فيه، مع تمكنه من نواصي اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية جعلته يملك زمام موضوعه بهذه الأدوات العلمية التي قل أن يظفر بها أحد من المعاصرين” الطاهر ص 345 ومما يشهد بهذه الحقيقة ذلك المستوى الرفيع من الأداء الترجمى، وذلك التنوع في موضوعات الكتب المترجمة على الرغم من انه يعد في مجلة المتخصصين على نحو ما سنورده لاحقا.
ثالثا: البعد القومي
لم يكن عادل زعيتر ينطلق من فراغ، ولم يقم بما أنجزه دون حافز، بل انه لم يندفع إلى عمله استجابة لمآرب خاصة، بل كان حاديه في كل ما فعل هو ما كان عليه وضع الأمة من سوء، وتكالب القوى الاستعمارية عليها، وتردي أحوالها، وتخلفها الثقافي، بعبارة أخرى، لقد كان عمله مسيَّسا يهدف به إلى رفع شأن الأمة، ولذلك راح يترجم للأعمال التي أثرت عميقا في المجتمع الأوروبي عموما، والفرنسي خصوصا، أملا في أن تحدث تلك الأعمال في شعبه ما أحدثته في الغرب.
“إن الرسالة التي اختارها من أبواب الفكر والفلسفة، وليست من نوع تجاري ليملأ جيبه من ورائها في روايات وأقاصيص أو ما سهل علاجه من الترجمات، بل تعلق بغرض هو أسمى ما تتطاول إليه عقول نَقَله الأفكار من كل حضارة.. ولكنه حدد رسالته وعينها، ووثق من حاجة أمته إليها، وأمن من نفسه الكفاية العلمية لأداء هذا الغرض على أتم وجه وأنفعه وأبدعه. فكان في اختياره كتابا للترجمة يُعنى بأن يكون مما تحتاج إليه الأمة العربية، وإلا يكون له نظير في لغتها…” الأرناؤوط 28، 29 انه بذلك يستحق أن يوصف بأنه كان قَيّما على الأمة يرعاها بما أوتي من جهد، ويسهر على مصالحها أملا في إصلاح ما يمكن إصلاحه من شأنها.
ويتضح البعد القومي في سيرته بحرصه على ترجمة بعض الكتب التي كان “يعتقد بوجوب نقلها إلى العربية، وكان يرجو أن تتيح له الأقدار عمرا يستطيع فيه أن يتولى هو هذا النقل ككتاب سير الأبطال لبلوتارك.. الذي كان يعجب به كل الإعجاب، ويرى أن ترجمته ضرورية، ويتحسر ألا يقرأ العرب هذا لكتاب لخالد.. (الأرناؤوط ص 35) وشبيه بذلك ما ورد في مقدمة ترجمته لكتاب بسمارك من قوله (ص 3) “نقدم هذا الكتاب إلى الأمة العربية في وقت هي في اشد الاحتياج إلى مثله، فلعل العرب يبصرون من مطالعته كيف تقام الجامعات، وكيف توحد الشعوب والدول على أسس صحيحة..”
وكان عادل زعيتر حريصا أشد الحرص على ترجمة الكتب التي انصف مؤلفوها الأمة الإسلامية وعلماءها، على طريق بعث أمجاد الأمة، وبيان فضلها بشهادة الأجانب، فقد جاء في مقدمة ترجمته لكتاب حضارة العرب لمؤلفه جوستاف لوبون (ص 7)” أكون قد أدخلت كتب لوبون المهمة الأخذ بعضها برقاب بعض إلى العربية إدخالا يخيل إلى الباحث معه أن هذا الحكيم الجليل من العرب، ولا عجب، فلوبون واضع سفر “حضارة العرب” وأكثر من ذلك، فقد كان عادل زعيتر “يعني بالرد على كل خطأ يقع فيه المؤلف خاصة إذا اتصل بتاريخنا” الجندي – تطور الترجمة ص 77 والنثر العربي ص 568.
لقد آمن عادل زعيتر بأن تحرر الأمة رهين بقيادة سليمة، وبتنظيم دقيق لحركة وطنية بين العرب، “فقرر أن يضع تحت تصرف الزعماء الوطنيين الفلسطينيين خلاصة الأفكار الأوروبية في القومية، ولذلك فقد خصص جل وقته للترجمة، ولكونه متشربا الثقافة الفرنسية ومؤمنا بان فكرة القومية الحديثة نشأت في فرنسا، فقد ترجم للكتاب الفرنسيين المشهورين بشكل خاص” أبو غزالة ص 44. وقد عبر أبو غزالة عن هذا التوجه لدى عادل زعيتر في موضع آخر من كتابه “الثقافة القومية في فلسطين” بقوله “ولا يزال هناك مظهر آخر للنهضة الأدبية في فلسطين تحت حكم الانتداب، هو ترجمة المؤلفات الغربية من الإنجليزية والفرنسية غالبا، وتعكس هذه المترجمات الوعي الوطني لدى المترجمين، لقد حاول بعض هؤلاء الرجال، مثل عادل زعيتر، أن يعرفوا أبناء بلدهم (وأمتهم) على الفكر السياسي في الغربي في الحكم الشعبي وأفكار أخرى حول الحكومة” (ص 92).
أجل، لقد كانت الترجمة عينا أخرى على الغرب، وكانت أعمال عادل زعيتر أجلّ ما وقعت عليه تلك العين، وما نرى إميل توما إلا قاصدا أعمال عادل زعيتر في مقالته “مدخل البحث في الثقافة العربية” (الجديد ص 6) حيث قوله “كما أن هذه الثقافة لم تتقوقع في التراث القديم على الرغم من ظهور دعاة إلى ذلك، بل آثرت الانفتاح على الثقافة الأوروبية، واستوعبت مبادىء الثورة الفرنسية وأقبلت على نتاج الأدباء والمفكرين وبخاصة الفرنسيين والروس”.
ولم يكن عادل زعيتر يرى فاصلا بين الدين والقومية، بل كان في توجهه القومي مسلما شديد التمسك بتعاليم دينه والمبادئ التي يقوم عليها. ويتضح ذلك في كثير من مواقفه وملامح سيرته، ومن ذلك ما واجهه في ترجمة ابن الانسان السيد المسيح عليه السلام، من تردد طويل توّجه بقوله: إنني كمسلم لا أوافق المؤلف على ما ذهب إليه في أمر السيد المسيح” الجندي – المحافظة والتجديد ص 571.
رابعا: الدقة
تتصف مترجمات عادل زعيتر بدقة بالغة، وكان يذهب بعيدا في ترجمته فيغير على المفردات الرصينة، وقد لا نعجب من ذلك، إذ عاش زعيتر في فترة شهدت توجها عاما نحو إحياء التراث واللغة بوجه خاص. وتظهر دقته في انتقاء مفرداته، واختيار معانيه، وضبطه الألفاظ بالشكل، وشرح غامضها، وتنوير بالنص بما يجلو مبهمة، ويفسر غريبه، ناهيك عن تأنقه في كل عمله. ويتضح هذا المنهج في سيرته وعمله في قول محمد الحلبي صاحب دار إحياء الكتب العربية في القاهرة في حينه “إنني أدير مطبعتنا منذ اثنين وثلاثين عاما، وقد تعاملنا في أثناء ذلك مع عدد كبير جدا من المؤلفين والمترجمين والمحققين من مصر وسائر البلاد العربية والإسلامية، فلم أجد أدق من الاستإذ عادل زعيتر في عنايته بتصحيح كتبه وسهره عليها وحرصه على إتقانها” الأرناؤوط ص 30 هـ1.
ويتفق مع الدقة فهم النص والتعمق في ذلك بسبر غوره، والنفاذ غلى روح الكاتب، ومما أثر عن عادل زعيتر قوله بهذا الصدد ” إن مهمة المترجم ليست نقل العبارة الأجنبية إلى العربية، بل إن هناك ما هو أهم وأعظم من هذا بمراحل كثيرة، وهو أن ينفذ المترجم إلى روح الكاتب، وأن يفهم شخصية المؤلف تمام الفهم” خورشيد ص 57.
ولأن ينفذ المترجم إلى روح الكاتب يقتضي ألا تكون الترجمة حرفية، ذلك لما بين اللغات من تفاوت في مناهج التعبير وطرق النظم، ولكن عادل زعيتر “كان يلتزم بحرفية النص مع التصرف في حدود الخير بعد قراءة كل المراجع التي تتصل بالكتاب الذي يترجمه” الجندي – تطور 77، حتى لكأنها وضعت أصلا بالعربية “والمترجم البارع هو من ينقل الكتاب إلى لغته وكأنه هو المؤلف ” الجندي – تطور 79.
وكان من تمام الدقة في أعماله انه لم يكن يركن في تدقيق مسوداتها وتجارب طبعها إلى أي احد كان، وإنما كان يقوم بذلك بنفسه، يقول صديقه محمد علي الطاهر (ص 348) في هذا الصدد “وان سألني سائل أين المال الذي قبضه عادل من دور الطبع والنشر مقابل ترجمته تلك المكتبة التي قدمها لأمته، فأني مخبر السائل بأن عادلا كان يدفع قيمة أتعابه إلى شركات الطيران وفنادق القاهرة حين كان يأتيها ويقيم فيها ثلاثة أشهر في كل عام لتصحيح (بروفات) هذه الكتب.. لأن إتقان مترجماته لا يتم في نظره إلا إذا طبعت صحيحة، وأن تطبع أتقن وأجمل طبع”.
ولا شك في أن ذلك كله قد اضطره إلى بذل جهود مضنية، وكبده مشقات جساما، لأن الترجمة المحكمة إبداع وأمانة، ناهيك عما كان يقتضيه حرصه على العربية وبعث ألفاظها مع مراعاة موافقتها للذوق والسلاسة، وعما كان يتجشمه جراء ذلك من نفقات إذ يقول”لم نتوخ الربح المادي، وكانت وجهتنا خالصة لوجه الثقافة والأدب وخدمة العرب مع ما كابدنا من جهود عنيفة مضاعفة في سبك عبارتها وجعلها بعيدة عن العجمة والألفاظ الحوشية ومع ما زهدنا عنه في أثنائها من كسب مناله من مهنة المحاماة وغيرها” الجندي – المحافظة والتجديد ص 568. وكان يتصل بأصدقائه وغيرهم يستشيرهم ويتحرى بعض المعلومات، فكان بذلك لا يخرج بترجمته على الناس إلا قد أوسعها تمحيصا، وأشبعها مراجعة وتدقيقا _راجع جبر – عادل زعيتر وفن الترجمة).
خامسا: التخصص
يعد التخصص سمة العصر الحديث، وهو مفض إلى الدقة والإتقان لا محالة، ذلك بما يتيحه للمرء من تمكن في سبر غور الموضوع. وقد كان عادل زعيتر متخصصا إلى حد كبير في مترجماته، فقد ترجم عن الفرنسية، وفي مجالات متداخلة متناصية في موضوعاتها. يقول حسام الخطيب (ص 71، 116) “…سجلت الفرنسية وجودا خاصا عن طريق عادل زعيتر الذي أغنى المكتبة العربية بترجمات من عباقرة المؤلفين الفرنسيين وإذا كانت الترجمات العلمية والوظيفية قد سجلت طغيانا فائقا للغة الإنجليزية فان الترجمات الفكرية والأدبية ظلت تجنح باتجاه اللغتين الروسية والفرنسية”، ويقول في موضع آخر (ص 83، 139، 140) “ولا بد من ختام هذا البند حول ظاهرة التخصص الايجابية (في الترجمة) من التذكير بان لهذه الظاهرة جذورا في تاريخ الترجمة الفلسطينية بدأها المترجم الفلسطيني الأول خليل بيدس وتابعها بجدية مثيرة للإعجاب عدد من رجال الرعيل الأول أبرزهم عادل زعيتر (في مجال التاريخ والسياسة والمجتمع) ونجاتي صدقي (في المجال الأدبي).
وكان لسعة ثقافته لا يترجم وحسب، وإنما كان يبدي رأيه مؤيدا أو معارضا بين حين وآخر، فجاءت مترجماته حافلة بآرائه النقدية وبتعليقاته وتصويباته. “إن المتتبع للآثار التي خلفها الاستإذ عادل زعيتر في حقل الترجمة يجد له فيها دورا لا يقل أهمية عن دور الترجمة، ألا وهو دور الناقد النافذ البصيرة، حيث يتصدى للجوانب التي جانب الصواب فيها المؤلف، ناقداً، معلقا، معيداً الكاتب والكتاب والقارئ إلى الرأي القوي السديد ” (الأرناؤوط ص 36).
سادسا: الكثرة
يمتاز عادل زعيتر عن غيره من المترجمين بكثرة ما ترجمه من الكتب، ولا نعرف من ترجم أكثر مما ترجم عادل سوى خيري حماد، إذ بلغت عدة مترجماته نحوا من مائة كتاب (الخطيب ص 71)، غير أن في ضخامة الكتب التي ترجمها زعيتر ما يرقى بجهوده إلى مرتبة عالية، إذ يقع كثير من كتبه في عدة مجلدات.
وبلغ من حرصه على الإكثار انه قال مرة لأخيه أكرم “حين يبلغ ارتفاع كتبي مرصوصة بعضها إلى بعض طول قامتي ينتهي أجلي” فأجابه الأستاذ أكرم” على أن تطبع على ورق رقيق رقة ورق السيجارة، فسره الجواب” الأرناؤوط ص 35، لقد بلغت كتبه ومحبّراته أضعاف طوله، وكان مع كثرة إنتاجه مجيدا أيما إجادة.
وأخيرا، لقد كان عادل زعيتر ظاهرة نادرة، وعلامة بارزة على طريق التحضر العربي المعاصر، عمل في مجالات مختلفة، في المحاماة والسياسة والترجمة، ولم يكن في فكره مقلدا، بل كان مبدعا مجددا وقد وجد في الفكر الغربي المعاصر، لاسيما أعمال جان جاك روسو وفولتير ما رسّخ لديه هو وجيله الأفكار القومية والثورة الاجتماعية والتحرر، مما أدى إلى تكوّن تيار فكري جديد يقوم على أساس من الرابطة القومية، ولعل هذه الحقيقة هي التي جعلت شتفان فلد (ص 388) يقول في عادل زعيتر وترجماته “انه مع روسو وفولتير يكون قد اختار خصمين رئيسيين لجمال الدين الأفغاني”.
وما نظن عادلا كان يرى فرقا كبيرا بين الرابطتين الشرقية الإسلامية والقومية العربية، وما نظنه عمد إلى ترجمة أعمال فولتير وجان جاك روسو انطلاقا من عداء لجمال الدين الأفغاني وطروحاته الفكرية، أو لفكرة الرابطة الإسلامية، فقد كان “يعجبه التدين في المرء من غير تعصب، وكان محبا للاطلاع على الفقه الإسلامي، ويقرأ القرآن مرة كل عام قراءة تدبر وتفهم، ويقارن بين مختلف التفاسير والسير، وإذا عرضت قضية شرعية كان عادل الحجة التي لا تنازع، وهو إلى تقواه وأدائه للفروض الدينية أداء كاملا، كان نير الفكر إصلاحيّ النزعة، وكان معجبا بالشيخ محمد عبده، وبسعة اطلاع الشيخ محمد رشيد رضا…” الأرناؤوط ص 34.
باختصار، إن عادل زعيتر يمثل بجهوده وتطلعاته مرحلة متميزة من مراحل التحضر العربي في العصر الحديث، ويضاهي في أعماله وآثارها ما أحدثته الترجمة عن اليونانية واللاتينية في العصر العباسي، وما أحدثته حركة الترجمة عن العربية إلى اللغات الأوروبية في الحقبة الاندلسية من أثر في التحضر الأوروبي في العصور الوسطى مما ترك بعض ظلاله على العصر الحديث، هذا العصر الذي نقل أوروبة وامتداداتها الحضارية نقلة جبارة في المجالات العلمية والاجتماعية والتقنية، ولما كانت حال الأمة الإسلامية على ما هي عليه من التخلف، فقد رأى عادل زعيتر في الفكر الذي أحدث في الغرب تلك الثورة الاجتماعية وذلك التقدم العلمي، رأى فيه فكرا صالحا لأن يحدث في أمته ما يفجر كوامنها، ويعجل مسلسل التفاعلات الاجتماعية المفضي إلى تبدل الحال إلى ما هو أفضل، ولذلك فقد بادر إلى نقل أمهات الكتب الفرنسية عن قصد وإصرار، هادفا إلى تنوير العقل العربي ورفد المكتبة العربية بما يثريها، وقد فعل ذلك كله منطلقا من علم جم، ودراية باللغات واسعة. فاستحق بذلك أن يتبوأ مكانة خاصة يمتاز بها عن سائر مترجمي العصر نظرا للدوافع السامية التي كانت تحركه، وللمواصفات الرفيعة التي اتصفت بها أعماله.
· عن دنيا الوطن
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …