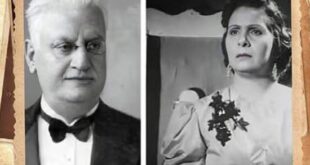رشيد وحتي
كلما مات مترجِمٌ، انقطعت معه سُبُل التواصل الإنساني بين بعض أصقاع العالَم. رحل أخيراً المترجم السوري أسامة منزلجي (اللاذقية ــــــ 1948-2025)؛ وفي مفارقةٍ غريبة، فكَّ خبر نعيهِ العزلة التي كان يعيشُها لآخر مرَّة بينَ مرَّات نادرة، إذ كان معروفاً حتى داخل مدينته على الساحل السوري بلزومِه بيتَه وسطَ كتبه وأسطواناته الموسيقيَّة.
حاز منزلجي الإجازة في الأدب الإنكليزي عام 1975 من جامعة دمشق، وترجم عن الإنكليزية إلى العربية ما يناهز الستين عملاً بين رواية ودراسة ومذكِّرات، ما يجعل مجهوده الفردي الجبَّار هذا، كمّاً ونوعاً، مساوياً لما تقوم به عادةً مؤسسة رسمية مدعومة أو مؤسسة خاصةٌ ذات ماليَّة ضخمة.
فرادة المشروع الترجمي للراحل لا تنبع فقط ممَّا نقله إلى العربيَّة، بل أيضاً من شخصِه وتكوينه الفكري والنفسي. يقول في مقابلة أجرتها معه الشاعرة هنادي زرقة (الأخبار/2/2017): “كنتُ صبياً لا يمكن أنْ يتلاءم إلا مع اختصاص يليق بكونه منعزلاً بامتياز، حواره الوحيد مع الكلام المكتوب والكلام الذي يدور في الرأس. لم أنجح مرة في إجراء حوار طويل مع أحد. ولدتُ لأكون مُصغياً”. وهكذا أمضى جلَّ حياتِه في صمتٍ مصغِياً إلى الكتب التي ترجَمها وإلى مؤلِّفيها.
دخلَ مضمارَ الترجمة عام 1980، مفتتِحاً مسارَه الاحترافي بِـ “ربيع أسود” لهنري ميللر، التي صدرت عن “دار ابن رشد” البيروتية اليساريَة العريقة التي توقَّفت للأسف كعدد من المشاريع التحررية بعد اجتياح بيروت عام 1982.
وبمراجعة قائمة منجزَاتِ الراحل، يتّضح بجلاء أنه كان صاحب مشروعٍ مفكَّرٍ فيه بروية وبذائقة فنية، رغم غياب أي نظريَّة عنها، إذ تكمن نظريَّتها بشكل منَ الأشكال في طريقة الانتقاء وممارسة النقل الإبداعي من الإنكليزية إلى العربيَّة وفقاً لمعايير شخصية ألزَمَ بها نفسَه: “ميللر هو المتمرد الصعلوك الذي أراد أنْ يُعيد تعريف كل شيء حسب ملاحظاته وتجربته في الحياة. أراد أنْ يُنهي الجملة التقليدية للتعبير عما يريد، والمفهوم التقليدي للعيب، أراد أنْ يستمد تجربته من التماس المباشر بالحياة وبالإنسان.
عندما رأيتُ اسمي مكتوباً على ترجمتي الأولى، شعرت بالمسؤولية، بأنني لا أريد أنْ يقترن اسمي بما يمكن أنْ يُسيء إليه: أردته أنْ يجذب الاهتمام والانتباه بوصفه جالباً لكلام يهتم بالإنسان ويبقى في الذاكرة”. وعليه نقل إلى العربيَّة جلَّ روائع هنري ميللر، التي بلغت عَشْراً من بينها “مدار الجدي” (1996)، و”مدار السرطان” (1997)، إلى جانب ترجمة “ذئب السهوب” (1997) و”إذا ما استمرت الحرب: مذكرات في الحب والحرب والسلام” (2014) لهيرمان هسه؛ و”الإغواء الأخير للمسيح” (2001) لنيكوس كازانتزاكيس؛ و”خزي” (2002) لكويتزي وغيرها الكثير من الروائع التي طبعت ذاكرة الأدب العالمي.
لدى مراجعة بقية منجزاته، يتبيَّن أنّه كان متسلِّحاً، ليس فقط بعدَّة الاحتراف الترجمي، وإنَّما أيضاً برؤية سياسية لا يغيب عنها الحسُّ الجمالي، قبل الشروع في نقل أيِّ كتاب إلى العربيَّة، وبابتعادٍ متعفِّف عن معايير فرضها الرأسمال في سوق الثقافة: “يهمّني في الدرجة الأولى الكتّاب الإنسانيون، المهتمون بالمصير الإنساني والمعاناة الإنسانية في هذا العالم، الكتّاب الذين يذهبون إلى الأسئلة الكبرى مباشرة، الذين لا يعترفون بالحواجز والموانع، الذين يسعون إلى الحرية الداخلية قبل الخارجية. كلما ازدادت شهرة الكتاب، قلَّ اهتمامي به؛ أنا لا أقرأ الكتب التي تحظى بشهرة واسعة؛ إنَّ لها سمعة مُريبة “.
· عن صحيفة الاخبار اللبنانية
اقرأ ايضا
المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض
مصطفى عطية جمعةمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على تجربتي رائدين من رواد المسرح العربي، ونعني …